
من المفروغ منه في عقيدة المسلم أن القرآن الكريم إنما هو قبل كل شيء كتاب هداية وإرشاد، كما قال تعالى في وصفه: {هدى للناس} (البقرة:185)، وقال: {يهدي إلى الرشد} (الجن:2). وبالتالي، فإن البحث فيه فيما وراء ذلك من تفاصيل وجزئيات أمر لا جدوى منه، بل هو مناقض لما أُنزل القرآن من أجله جملة وتفصيلاً.
وقد درج بعض المفسرين المتقدمين عند تفسيرهم لبعض الآيات، الخوض في جزئيات وتفاصيل سكت عنها القرآن، ولم يتعرض لها من قريب أو بعيد، وحاولوا بالتالي البحث عن المراد منها، وربما فسروها أو أولوها بما بدا لهم من رأي، أو بما وقفوا عليه من روايات ضعيفة، لا يصح التعويل عليها في تفسير كتاب الله.
وقد سلك المسلك نفسه بعض المسلمين اليوم، الذين يتعاملون مع القرآن قراءة وتفسيراً وفهماً، فتراهم يولعون بالخوض في بيان المراد من بعض الألفاظ، ويجتهدون في السؤال عن تفاصيل لا فائدة تجنى من معرفتها.
ولتقريب المشكلة أكثر، نحاول التمثيل لها بمثال. يقول تعالى في أثناء ما قصه علينا من قصة البقرة: {فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى} (البقرة:73)، فهنا يأتي بعض المفسرين، ويتابعهم في ذلك من لم يفقه مقاصد القصص القرآني، ويحاول أن يفسر المراد بـ (البعض) الذي ضُرب به ذلك الميت، فعادت إليه الحياة، فيقول: المراد بهذا البعض: العظم الذي يلي الغضروف. ويقول آخر: ضربوه ببعض لحمها، ويقول ثالث: ضربوه بذنبها. وثمة من يقول: ضربوه بفخذها. وهناك روايات أخر تُذكر بهذا الصدد.
وقد نبه عدد من المفسرين المتقدمين على عدم جدوى مثل هذا المسلك. فهذا شيخ المفسرين الطبري يقول: "والخير للمفسر...أن يُعرض عما لا طائل منه، ويعد صارفاً وشاغلاً عن الأصول المعتمدة في شرعنا، وهذا أحكم وأسلم" .
أما ابن كثير فيقول في أثناء تفسيره لقوله تعالى: {بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد} (الإسراء:5)، يقول: "وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية، لم أر تطويل الكتاب بذكرها...ونحن في غُنْيَة عنها، ولله الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية".
وأيضاً، فإن المفسرين المعاصرين تنبهوا ونبهوا على عدم جدوى مثل هذا المسلك في التعامل مع القرآن، فنأوا بأنفسهم عن الخوض في تفاصيل وجزئيات لا طائل في الوقوف على تحديدها، وبيان المراد منها.
فهذا الشيخ الشنقيطي يقول بهذا الصدد: "ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة، لم يبينها الله لنا ولا رسوله، ولم يثبت في بيانها شيء، والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه".
ويقول سيد قطب في أثناء تعليقه على الروايات المنقولة حول قصة موسى وقارون: "ولسنا في حاجة إلى كل هذه الروايات، ولا إلى تحديد الزمان والمكان. فالقصة كما وردت في القرآن كافية لأداء الغرض منها في سياق السورة، ولتقرير القيم والقواعد التي جاءت لتقريرها. ولو كان تحديد زمانها ومكانها وملابساتها يزيد في دلالتها شيئاً ما ترك تحديدها".
ويدلي الشيخ أبو الحسن الندوي بدلوه في نقد هذا المسلك عند المفسرين، فيقول: "الغاية الأساسية من نزول القرآن، هي تهذيب النفوس البشرية، والقضاء على العقائد الباطلة، والأعمال الفاسدة...أما القصص الجزئية، والحكايات المعينة التي أتعب المفسرون نفوسهم في نقلها، وأطالوا النَّفَس في ذكرها، والحديث عليها، فليس لها دخل كبير، ولا أهمية ذات بال".
أما الشيخ ابن عاشور فيقول في أثناء تفسيره لقوله تعالى: {أخرجنا لهم دابة من الأرض} (النمل:82): "وقد رويت في وصف هذه الدابة ووقت خروجها ومكانه أخبار مضطربة ضعيفة الأسانيد، فانظرها في «تفسير القرطبي» وغيره؛ إذ لا طائل في جلبها ونقدها".
ويمكن تتبع بعض الأمثلة على هذا المسلك وفق التالي:
عند تفسير قوله تعالى: {ن والقلم وما يسطرون} (القلم:1)، يذكر ابن كثير أن (النون) في الآية: الحوت، ثم ينقل عن البغوي وجماعة من المفسرين قولهم: إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات والأرض، وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن، وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن! فمثل هذه الأقوال والروايات لا ينبغي أن يعول عليها، ولا أن يلتفت إليها؛ إذ لا يترتب على معرفتها -على فرض ثبوتها- تكليف.
ونحو ذلك خوض المفسرين في المراد بـ (الصخرة) في قوله تعالى: {فتكن في صخرة} (لقمان:16)، فيذكرون أن هذه الصخرة على قرن ثور، وبعضهم يقول: إنها صخرة في الريح. ومن هنا وجدنا ابن عطية يُعقِّب على مثل هذا بقوله: "وكل ذلك ضعيف لا يثبت سنده. وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم. أي: إن قدرته عز وجل تنال ما يكون في تضاعيف صخرة، وما يكون في السماء، وما يكون في الأرض".
ومن الأمثلة على هذا المسلك أيضاً، الخوض في تعيين بعض الأعداد التي ذكرها القرآن، كالاختلاف حول عدد الفتية الذين ورد ذكرهم في سورة الكهف في قوله تعالى: {سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم} (الكهف:22)، ففي هذه الآية خاض بعض المفسرين في تحديد عدد أولئك الفتية الذين آوهم الكهف. ووصل الحد ببعضهم للبحث عن اسم الكلب الذي كان مرافقاً لهم في كهفهم، وثمة من بالغ أكثر، فأراد معرفة لون ذلك الكلب، أأسود كان أم أبيض؟!
والجدل حول عدد الفتية -كما يقول سيد- لا طائل وراءه. وإنه ليستوي أن يكونوا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، أو أكثر. وأمرهم موكول إلى الله. والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل وبالكثير. لذلك يوجه القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ترك الجدل في هذه القضية، وإلى عدم استفتاء أحد من المتجادلين في شأنهم؛ تمشياً مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تُبَدَّد في غير ما يفيد.
ومن هذا القبيل، الخوض في صفة (الصور)، الذي ورد ذكره في قوله تعالى: {ونفخ في الصور} (يس:51)، فما صفة هذا الصور، وما حجمه، وما نوعه، كل ذلك أمور لا تغني معرفتها من الحق شيئاً. وكل ما يجب اعتقاده بهذا الخصوص، أن نؤمن أن هناك نفخة في الصور -وهو البوق- تحدث بعدها أحداث، ولا نزيد في تفصيلها شيئاً، والتفصيل لا يزيد في حكمة النص شيئاً، والجري وراءه عبث لا طائل تحته.
ونحو ذلك الخوض في تعيين (الشجرة) التي نهى الله آدم عن الأكل منها، في قوله: {ولا تقربا هذه الشجرة} (البقرة:35)، فقد اختلف المفسرون اختلافاً لا طائل تحته، في تعيين هذه الشجرة؛ فمن قائل: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم يقول: هي شجرة التين، إلى غير ذلك من الأقوال. وكل ذلك مجاف لقصد القرآن من ذكر هذه الواقعة.
ومما خاض فيه المفسرون أيضاً، تحديد طبيعة (اللباس) الذي كان على كل من آدم وحواء، الذي ذكره القرآن في قوله سبحانه: {ينزع عنهما لباسهما} (الأعراف:27)، فقد قيل في تحديد هذا اللباس: كان لباسهما نوراً يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس من ياقوت، إلى غير ذلك من الأقوال. وهذا أيضاً من الاختلاف الذي لا طائل تحته، ولا دليل عليه.
وخاضوا في تحديد بعض الأماكن التي ذكرها القرآن، كمكان (البحرين) اللذين ورد ذكرهما في قوله تعالى: {لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين} (الكهف:60)، ومعلوم أنه لا فائدة تُرجى من معرفة مكان هذين (البحرين)، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته، وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه.
ومما جرى هذا المجرى خوض بعض المفسرين في تحديد مكان (الوادي) واسم (النملة) وصفتها، اللذين ورد ذكرهما في قوله تعالى: {حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة} (النمل:18)، مع أنه لا طائل من البحث في مكان الوادي، ولا في صفات هذه النملة واسمها، وحسبنا في هذا ما أخبرنا عنه القرآن مجملاً من غير تفصيل.
ومن الاختلافات المشهورة بين المفسرين، خلافهم في المراد من (الروح) المذكور في قوله تعالى: {ويسألونك عن الروح} (الإسراء:85)، فيذكرون أقوالاً عديدة في تحديد هذه (الروح)، فيقول بعضهم: القرآن. ويقول بعضهم: جبريل. ويقول آخرون: عيسى عليه السلام. ويقولون غير ذلك مما لا طائل تحته، مع أن القرآن الكريم صرح أن علم ذلك عند الله سبحانه لا عند سواه.
وخاضوا أيضاً في ذكر صفات بعض الأمور التي قررها القرآن، كتحديد صفة (الطيور) الأربعة الوارد ذكرها في قوله: {فخذ أربعة من الطير} (البقرة:260)، فقد اختلف المفسرون في هذه الأربعة: ما هي؟ ولا ريب أنه لا فائدة ترجى من تحديد صفتها.
وخاضوا في تحديد نوع (الرجز) الذي أنزله الله على بني إسرائيل، واسم الغلام الذي قتله الخضر، وخشب سفينة نوح من أي شجر هو، وكم طول السفينة وعرضها، وكم فيها من الطبقات، وصفة ذي القرنين ومَن الذي سأله، وصفة أجنحة الملائكة، وصفة عرش الملكة بلقيس. إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنه، ولا دليل على التحقيق فيه.
ومثل هذه الأمور لا يخلو منها تفسير على الجملة، فإن كثيراً من المفسرين المتقدمين خاضوا في أمور كان الأولى تركها وتجاوزها؛ وأتعبوا نفوسهم في نقلها، وأتعبوا من بعدهم في قراءتها، ولا أهمية ترجى من ورائها. ولو كان ثمة فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا في تعيين وتبيين شيء من ذلك، لبينه الله تعالى لنا. وقد قرر أهل العلم أن كل مسألة لا يترتب عليها عمل، فالخوض فيها عبث.
على أن ما تقدم لا يعني أن نضرب صفحاً عن كتب التفسير جملة وتفصيلاً، بل المطلوب التنبه لمثل هذه الأمور، وعدم التوقف عندها، أو الخوض في تفسيرها. وقد أبى سبحانه أن يصح كتاب غير كتابه، وكل الناس يؤخذ منه ويرد إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج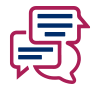 استشارات الحج
استشارات الحج

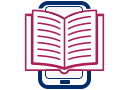












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات