 عندما سُئل أحد قادة الجيش الإسرائيلي عن الصعوبات التي تواجهها قواته في التصدي لصواريخ "القسَّام"، التي يطلقها الفلسطينيون على المستوطنات الإسرائيلية، رد مازحاً أن الحل هو أن تزوِّد إسرائيل الفلسطينيين بصواريخ "سكود"، حيث أن لديها أنظمة دفاعية قادرة على إسقاطها!. بهذه الطرفة الواقعية، يستهل المحلل العسكري الإسرائيلي زئيف شيف مقاله بعنوان "لا حل لصواريخ القسَّام" (صحيفة هآرتس، 3 سبتمبر 2004). ولعل هذا الاستهلال الذي لا يخلو من سخرية، فضلاً عن العنوان الذي ينم عن اليأس، كافيان للدلالة على الإحساس العام الذي يسود المقال بأكمله، كما يتبدى بصورة أو بأخرى في كتابات المحللين الإسرائيليين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، ومؤداه أن الآلة العسكرية الإسرائيلية بكل إمكاناتها المتقدمة عاجزة حتى الآن عن مواجهة الأسلحة البدائية التي يستخدمها المقاومون الفلسطينيون.
عندما سُئل أحد قادة الجيش الإسرائيلي عن الصعوبات التي تواجهها قواته في التصدي لصواريخ "القسَّام"، التي يطلقها الفلسطينيون على المستوطنات الإسرائيلية، رد مازحاً أن الحل هو أن تزوِّد إسرائيل الفلسطينيين بصواريخ "سكود"، حيث أن لديها أنظمة دفاعية قادرة على إسقاطها!. بهذه الطرفة الواقعية، يستهل المحلل العسكري الإسرائيلي زئيف شيف مقاله بعنوان "لا حل لصواريخ القسَّام" (صحيفة هآرتس، 3 سبتمبر 2004). ولعل هذا الاستهلال الذي لا يخلو من سخرية، فضلاً عن العنوان الذي ينم عن اليأس، كافيان للدلالة على الإحساس العام الذي يسود المقال بأكمله، كما يتبدى بصورة أو بأخرى في كتابات المحللين الإسرائيليين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، ومؤداه أن الآلة العسكرية الإسرائيلية بكل إمكاناتها المتقدمة عاجزة حتى الآن عن مواجهة الأسلحة البدائية التي يستخدمها المقاومون الفلسطينيون.ويصل الكاتب إلى هذه النتيجة من خلال استعراض للتحدي الذي تمثله هذه الصواريخ التي طورتها "كتائب عز الدين القسام"، "الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، وأصبحت مصدر إزعاج دائم للمستوطنين الصهاينة وللأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. فهو يقر بأن سرعة إطلاق هذه الصواريخ، في أقل من دقيقة، إلى أهداف تمتد على مساحات واسعة يجعل من الصعب تتبعها وإسقاطها، بالرغم من أن "إسرائيل" لديها أجهزة متطورة يمكنها أن تحدد على وجه السرعة مواقع إطلاق الصواريخ الأخرى. ويشير الكاتب إلى أن مدى صواريخ "القسَّام" يصل حالياً إلى حوالي ثمانية كيلومترات، ولكن ثمة دلائل على أن الفلسطينيين قد يتمكنون في المستقبل من الحصول على صواريخ أخرى يصل مداها إلى 20 كيلومتراً أو أكثر، وهو ما يتيح إصابة أهداف أكثر عمقاً وتأثيراً.
ويثني الكاتب على الجهود التي تبذلها الأجهزة العسكرية الإسرائيلية لإيجاد حل للتهديد المستمر الذي تمثله صواريخ "القسَّام"، ومن بينها على سبيل المثال تدمير بعض ورش الحدادة في قطاع غزة، والتي يُعتقد أنها تُستخدم في صنع الصواريخ، ولكنه يعود ويعترف بأنه "على الرغم من قصف كثير من هذه الورش فإن الفلسطينيين يواصلون تصنيع الصواريخ".
ويرى زئيف شيف، عن حق، أن ما تعانيه "إسرائيل" في مواجهة صواريخ "القسَّام" لا يختلف كثيراً عما تعانيه القوات الأميركية في العراق حالياً وما عانته من قبل في مناطق أخرى من العالم. وفي لهجة أقرب إلى الرثاء يسلِّم الكاتب بأن ""إسرائيل" تعلمت ما سبق أن تعلمته الولايات المتحدة في حرب فيتنام وفي حربي الخليج، وهو أن أكثر التقنيات تقدماً تجد صعوبة في التعامل مع الأسلحة البدائية".
والواقع أن المشاكل المستعصية التي يسوقها المحلل العسكري الإسرائيلي لا تعدو أن تكون جانباً واحداً فحسب من أزمة أعمق تواجهها الدولة الصهيونية ويزداد الوعي بها يوماً بعد يوم لدى مختلف شرائح المستوطن الصهيوني على أرض فلسطين، حتى وإن بدا أحياناً أنها تتوارى خلف "النجاحات" المؤقتة التي تحققها الآلة العسكرية الإسرائيلية، مثل اغتيال قائد أو أكثر من قادة المقاومة الفلسطينية أو اعتقال المئات من المقاومين أو إحباط عملية فدائية هنا أو هناك أو اجتياح المدن والقرى الفلسطينية وفرض الحصار عليها أو تدمير أحياء بكاملها أو تخريب مساحات شاسعة من الأراضي. وتتمثل هذه الأزمة في قدرة الشعب الفلسطيني على ابتكار وتطوير أساليب نضالية جديدة تتحدى أحدث منجزات العسكرية الصهيونية وما يكمن وراءها من نظريات أمنية. ولعل أخطر ما في هذه الأزمة أنه لا يبدو في الأفق أي مخرج للفكاك منها، فكل أساليب البطش والتنكيل تقف عاجزة حتى الآن عن كسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني أو اثنائه عن مواصلة النضال من أجل حقوقه المشروعة.
وتعد صواريخ "القسَّام" من الملامح المميزة للتطور النوعي الذي حققته الانتفاضة الفلسطينية، وهي تعكس في الوقت نفسه بعضاً من خصائص "الإبداع الانتفاضي" الذي أصبح يشكل هاجساً مزعجاً للمستوطن الصهيوني. فالصواريخ عبارة عن قذائف يمكن تصنيعها يدوياً داخل البيوت، دونما حاجة لبنية صناعية متقدمة أو متطلبات إنتاجية معقدة أو خبرات خاصة، وهو ما يجعل من السهل انخراط مختلف فئات المجتمع من شتى الأعمار في عملية الانتاج، ويزيد في المقابل من صعوبة تتبع مراحل التصنيع أو وقفها. وتتكون هذه القذائف من خليط من السكر والزيت والكحول والأسمدة العضوية، وهي مواد متوفرة في كل بيت تقريباً وتُستخدم لأغراض متنوعة ولا يمكن تجريم أحد لمجرد حيازتها، ومن شأن اتساع "البنية الأساسية" لهذه الصناعة على هذا النحو أن يجعل من العسير، إن لم يكن من المستحيل، القضاء عليها.
والأهم من هذا كله أن عملية التصنيع بهذه المواصفات تصبح جزءاً من نسيج الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، كهلاً كان أو امرأة أو طفلاً، بل وتصبح رمزاً للإصرار على المشاركة ولو بنصيب ضئيل في فعل الانتفاضة المتجدد والمتواصل. وقد كان تحويل الانتفاضة إلى واقع يومي أبرز إنجازات الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1987، وجاءت انتفاضة الأقصى لتواصل نفس النهج مستفيدةً من الخبرات الحياتية والنضالية التي تراكمت على مدار سنوات المقاومة.
إلا أن صواريخ "القسَّام" لم تكن الملمح الوحيد لهذا التطور النوعي. فهناك صواريخ "البنَّا" التي بدأت حركة "حماس" في إطلاقها في إبريل 2004، وهناك صواريخ "القدس "، التي أعلنت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد"، عن إطلاقها في نفس الفترة، وهناك بالإضافة إلى هذا وذاك نجاح المقاومين الفلسطينيين بأسلحة بسيطة في تدمير أكثر من دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، التي تُوصف بأنها أكثر الدبابات تحصيناً في العالم وكانت تُعد حتى وقت قريب "رمزاً للعسكرية الإسرائيلية"، وهو الأمر الذي حدا بكثير من المعلقين العسكريين الإسرائيليين إلى القول إن الصدمة النفسية والرمزية التي أحدثها تدمير هذه الدبابة تفوق بكثير مجرد الخسارة العسكرية، إذ تقدم دليلاً جدياً على أن أعتى المعدات العسكرية المتقدمة لا يمكنها أن توفر الأمان للمستوطن الذي يظن أن الأرض التي اغتصبها "أرض بلا شعب".
ولعل العجز الإسرائيلي في مواجهة صواريخ "القسَّام"، وغيرها من أساليب المقاومة التي أبدعها الشعب الفلسطيني خلال انتفاضته المستمرة، يعيد إلى الأذهان سؤالاً قديماً أجابت عليه خبرات التاريخ مراراً وتكراراً، ومع ذلك يتجاهله عن عمد في كثير من الأحيان أولئك الذين يتطوعون بإسداء نصائح الاستسلام إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وهو مَنْ الأقوى في نهاية المطاف: جيوش الغزو المدججة بأحدث الأسلحة الفتاكة أم الشعوب التي تقاوم مسلحةً بعدالة الحق ونبل الهدف والإصرار على نيل الحرية؟.
والله أعلم.
صحيفة الاتحاد الإماراتية 11/9/2004


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج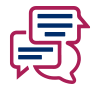 استشارات الحج
استشارات الحج

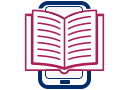












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات