
يتصور الكثيرون أن الصراع العربي الصهيوني هو صراع إعلامي بالدرجة الأولى، وهو وهم لا أساس له. صحيح أن الإعلام مهم، بل في غاية الأهمية، ولكن مهمته تنحصر في نقل رسالة إلى العدو مؤداها أن المقاومة مستمرة، وأنه لا يمكن لشارون وأمثاله إخماد المقاومة. ومن مهام الإعلام أيضاً التوجه إلى الرأي العام العالمي لإظهار عدالة القضية العربية، وكسب تأييد جماهير هذه البلاد من أجل الضغط على حكوماتها لتغيير مواقفها. أما تصور أن الإعلام بمفرده بدون مقاومة قد يحوِّل موازين القوى لصالحنا، فهذا خداع للذات، فلابد أن تستمر المقاومة حتى يسمعنا العالم وتسمعنا جماهير العدو.
الوهم ينتقل إليهم
ويبدو أن وهم الإعلام قد انتقل إلى الصهاينة، فبعد أن ساءت صورتهم الإعلامية في العالم الغربي (60 في المئة من الشعوب الأوروبية وحوالي 37 في المئة من الأميركيين يرون أن الدولة الصهيونية هي أكبر تهديد للسلام في العالم)، اعتمدوا مبالغ طائلة لبعض شركات الدعاية والعلاقات العامة لتحسين صورتهم.
وقد ذكرت صحيفة "هآرتس" (1 يونيو2003) أن استطلاعاً للرأي في الولايات المتحدة بيّن أن 80 في المئة من الشباب الأميركي اليهودي لا يشعرون بأن هناك صلة تربطهم بالدولة الصهيونية أو حتى بالجماعة اليهودية وعلى رغم أنهم يعرِّفون أنفسهم بأنهم يهود أميركيون، فإنهم يؤكدون انتماءهم الأميركي على حساب انتمائهم اليهودي، ويشيرون إلى الإسرائيليين باعتبارهم "هم" وليس "نحن". وعلاقة هذا الجيل بالعقيدة اليهودية ضعيفة للغاية، ولذلك فلا جدوى من محاولات حثهم من خلال العهد القديم، ومصطلحات مثل "أرض الميعاد" أو "الوعد الإلهي" أو "الميثاق مع الرب".
الانتفاضة فضحتها
وعند تفسير هذه الظاهرة لا يحاول الصهاينة الوصول إلى جذور القضية، وهي أن "إسرائيل" دولة استعمارية تحتل أرض الغير، وأن الانتفاضة فضحتها أمام الرأي العام الغربي، بما في ذلك الشباب الأميركي اليهودي، بل يكتفون بتقديم تبريرات لا تفسر شيئاً من قبيل أن هذا الجيل لم يحضر مرحلة تأسيس الدولة، عندما كانت ضعيفة، وأن المنظمات اليهودية فشلت في التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب اليهودي.
وللخروج من هذا المأزق يقدم فرانك لوتز، الذي أعد الدراسة، عدة اقتراحات إعلامية، ولا يمس جوهر الموضوع. فهو يطالب المنظمات اليهودية بوقف الإعلانات المكلفة التي تُنشر في صحيفة "نيويورك تايمز"، والحوار مباشرةً مع الشباب اليهودي. ولكن ما هو موضوع الحوار؟ ماذا لو ذكر الشباب اليهودي بطش القوات الإسرائيلية الذي يعرضه الإعلام الأميركي، على رغم كل المحاولات الصهيونية للحيلولة دون ذلك؟ لا يجيب لوتز على مثل هذه الأسئلة، بل يمضي مطالباً بالتوجه للشباب اليهودي حضارياً، بإحضار مغنين وممثلين كوميديين يؤكدون لهم العلاقة بين انتمائهم اليهودي وانتمائهم الأميركي. ولكن ألن يزيد ذلك من انصرافهم عن الدولة الصهيونية، ويعمق انتماءهم للولايات المتحدة؟
وقد ظهرت نصائح إعلامية مماثلة إبان انتفاضة عام 1987. فقد كتب (ديفيد برنباوم) وهو رجل أعمال أميركي وأستاذ العلوم الاستراتيجية في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك، مقالاً بعنوان: "في المعركة من أجل الرأي العام الأميركي: فلتذكر القصة فيما لا يزيد على عشر كلمات" ("جيروزاليم بوست"، 21 فبراير 1988). وقد اقترح حل المشكلة الإسرائيلية بطريقة إعلامية فحسب، فذهب إلى ضرورة الربط بين المنتفضين الفلسطينيين وزملائهم في بيروت وطهران! بحيث يضطر الأميركي البسيط أن يختار بين "واحة الديمقراطية" أو "الإرهاب العربي"!.
الترانسفير هو الحل
ولكن ثمة مشكلة بسيطة وهي أن هذا الأميركي البسيط قد لا يوافق على العنف، ولهذا يقترح "أستاذ العلوم الاستراتيجية" ما يلي: على الإسرائيليين (وسأنقل كلماته للقارئ حرفياً): "اقبضوا على الذين يلقون بالحجارة وسوقوهم إلى محاكم عسكرية محلية وحاكموهم بسرعة، ثم ضعوهم في الحافلات ولتلقوا بهم وبأطرهم المحترقة وحجارتهم خارج الحدود. لا تلوثوا أيديكم وإن كان لديكم عدد من سيارات الجيب تمتلئ ببعض أقارب ضحايا إرهاب منظمة التحرير الفلسطينية لتصاحب هذه الشخصيات (الإرهابية) فهذا أمر حسن، وإذا تبع هذا الموكب عدد آخر من سيارات الجيب المحملة بمجندات إسرائيليات جميلات لا يزيد عمرهن على 18 عاماً، فهذا أحسن وأحسن".
وهذا هو حل "الترانسفير" القديم بعد إعادة صياغته على هيئة إعلانات العطور التي تستخدم "السيكس أبيل"، فإن وضعت قطرة من هذا العطر السحري لوجدت كل إناث العالم في أحضانك! وهو يتصور أن الإنسان الغربي حينما يرى عويل "ضحايا" الجهاد الفلسطيني مضافاً إليه أرداف المجندات الإسرائيليات الجميلات فسينسى العظام التي تتحطم يومياً على الشاشة!
وبخلاف هذا المقال الذي يتسم بالتفاهة والسطحية، كتب (يحرقئيل درور)، أستاذ العلوم السياسية والإدارية في الجامعة العبرية، مقالاً بعنوان: "صورة جيكل وهايد" ("جيروزاليم بوست"، 12 إبريل/ 1988)، يبدأ بتعريف المشكلة كالتالي: "إسرائيل تقع على الحدود بين حضارات سياسية متنوعة وصلت إلى مستويات مختلفة من التطور. فمن ناحية يوجد العالم الغربي (المتقدم) الذي بلغ درجة من الاستقرار النسبي بعد تاريخ طويل من الاستعمارية العدوانية، ومن ناحية أخرى يوجد الشرق الأوسط (المتخلف) الذي يتسم بعدم الاستقرار والحروب والعصبية الدينية. فكيف يمكن لإسرائيل تلبية الاحتياجات المتناقضة الناجمة عن موقعها هذا؟ وكيف يمكنها صياغة صورتها الإعلامية؟ فالغرب يحكم على "إسرائيل" بمعاييره، وهي معايير لا يمكن تطبيقها في المواجهة مع العرب، لأن الغرب لا يُضطر لاتخاذ إجراءات قمعية كالتي تستخدمها "إسرائيل"، إذ لا يواجه سوى احتجاجات الطلاب والأقليات العرقية ودعاة حماية البيئة. أما الانتفاضة فتهدد وجود "إسرائيل" ذاته، ولهذا لابد أن تتخذ "إسرائيل" إجراءات تتناقض مع القيم السائدة في الغرب". ويقترح درور أن تكون صورة "إسرائيل" خليطاً من صورة جيكل الخيِّر وصورة هايد الشرير.
إلا إن صياغة مثل هذه الصورة المختلطة مسألة صعبة للغاية، خاصة أن صورة هايد "غير مقبولة للغرب بما في ذلك يهود العالم"، على حد قول درور. ولكن على "إسرائيل" أن تتصرف بهذه الطريقة وأن تؤكد (ولنترجم حرفياً) "الإمكانية الشيطانية" الكامنة فيها. وحتى لا يخطئ أحد فهم ما يعنيه الأستاذ الجامعي بعبارة "الإمكانيات الشيطانية" فقد عرفها بأنها "إظهار القوة الجسدية"، أي أنه الصراع الدارويني القديم دون زخارف، وهو المنطق الذي استخدمه الغرب في غزو العالم الثالث واستعباد شعوبه. ويرى الكاتب أنه يجب على "إسرائيل" أن تؤكد ضرورة تبني معايير للسلوك مناسبة لمواقف مختلفة عن تلك التي تواجهها البلاد الغربية. أي أن عليها تذكير الغرب مرة أخرى بتراثه القمعي الطويل القديم، وبأن السياق الحقيقي الوحيد للقمع الصهيوني هو الاستعمار الغربي.
ولكن مشكلة درور، أنه يرى المشكلة في إطار مكاني (والعقل الصهيوني أسير المكان فهو يخشى الزمان والتاريخ ويلغيهما) فالمشكلة بالنسبة له مشكلة "موقع" أي أن "إسرائيل" "توجد" أمام عدسة الكاميرا أو بين الشرق والغرب، بينما المشكلة في واقع الأمر مشكلة مرحلة أي زمن. وتتلخص المشكلة الزمنية في وجهين:
أولاً: أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني جاء متأخراً، بعد أن انحسرت المرحلة الاستيطانية من الاستعمار الغربي التي بدأت في القرن السادس عشر وانتهت مع نهاية القرن التاسع عشر. أي أن التجربة الصهيونية في الاستيطان الإحلالي بدأت بعد أن كان الغرب قد انتهى من إبادة من أباد، واستعباد من استعبدهم من شعوب، ولم تعد مثل هذه الأمور مقبولة لدى أمم الغرب (المتحضرة!) ولهذا يحتج العالم الغربي عندما يلجأ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لأشكال القمع المباشر الواضح نفسها التي كان يلجأ إليها الاستعمار الغربي في الماضي القريب، فمثل هذه الأمور تنتمي إلى مرحلة سابقة (لا إلى الموقع).
ثانياً: أن "إسرائيل" ظهرت كدولة في مرحلة ثورة شعوب العالم الثالث على الاستعمار، في إطار حركة التحرر الوطني، والتي أدت إلى تراجع الاستعمار التقليدي وظهور الاستعمار الجديد. وقد تأخرت هذه الحركة في فلسطين حتى منتصف الستينيات لظروف خاصة، وهي أن فلسطين جزء من الكل العربي واجه ظاهرة الاستيطان الإحلالي الفريدة في القرن العشرين. وقد التقط الفلسطينيون أنفاسهم وبدؤوا نضالهم الذي وصل إلى إحدى قممه في الانتفاضة، الأمر الذي يزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي للجيب الصهيوني.
وهذه الفجوة الزمنية، لا الموقع، هي سبب مشكلة إسرائيل الإعلامية والأخلاقية والسياسية، ولا يمكن لأية صورة مختلطة ذات رأسين أن تحل هذه المشكلة، فكلما ازداد الفلسطينيون انتفاضاً يزداد الإسرائيليون قبحاً، كما بينت انتفاضة الأقصى، التي أقنعت غالبية الشعوب الأوروبية أن "إسرائيل" هي أكبر تهديد للسلام.
ــــــــــــــــــــــــــ
صحيفة الاتحاد 7/2/2004


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج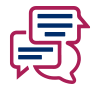 استشارات الحج
استشارات الحج

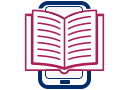












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات