
بعد سنين طويلة قضاها النبي - صلى الله عليه وسلم- في جهاد دائم ، وعمل متواصل لا يعرف الكلل ولا الملل ، وهو يطوف على القبائل ، مبلغاًُ دعوة ربه ، ملتمساً الحليف والنصير ، ملاقياً في سبيل ذلك صنوف الأذى والصد والإعراض ، أراد الله إتمام أمره ، ونصر دينه ، وإعزاز نبيه ، فكانت البداية ، ونقطة التحول الحاسمة ، وبصيص النور الذي أطلَّ من بين ركام الظلمات ، عندما قيض الله أولئك النفر الستة من أهل المدينة ، فالتقى بهم - صلى الله عليه وسلم - في موسم الحج من السنة الحادية عشرة للبعثة ، وعرض عليهم الإسلام ، فاستجابوا لدعوته ، وأسلموا - ، وكان هذا الموكب أولَ مواكب الخير التي هيأت للإسلام أرضاً جديدة ، وملاذاً أميناً ، حيث لم يكتف هؤلاء النفر بالإيمان ، وإنما أخذوا العهد على أنفسهم بدعوة أهليهم وأقوامهم ، ورجعوا إلى المدينة وهم يحملون رسالة الإسلام ، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- .
فلما كان موسم الحج من العام التالي جاء إلى الموسم اثنا عشر رجلًا من المؤمنين ( عشرة من الخزرج واثنان من الأوس ) فالتقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم- عند العقبة بمنى ، وبايعوه البيعة التي سميت " بيعة العقبة الأولى " ، وكانت بنود هذه البيعة نفس البنود التي بايع الرسول - صلى الله عليه وسلم- عليها النساء فيما بعد ، ولذلك عرفت أيضاً باسم " بيعة النساء " ، وقد روى البخاري في صحيحه نص هذه البيعة وبنودها في حديث عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه – وكان ممن حضر البيعة – وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لهم : ( تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمـره إلى الله ، إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه ) ،قال : " فبايعته " ، وفي رواية " فبايعناه على ذلك " .
ثم بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- معهم مصعب بن عمير ، يعلمهم شرائع الإسلام ، ويفقههم في الدين ، ويقرؤهم القرآن ، وينشر الإسلام في ربوع المدينة ، فأقام رضي الله عنه في بيت أسعد بن زرارة يعلم الناس ، ويدعوهم إلى الله ، وتمكن خلال أشهر معدودة من أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدينة ، وأن يكسب للإسلام أنصارًا من كبار زعمائها ، كسعد بن معاذ ، و أسيد بن الحضير ، وقد أسلم بإسلامهما خلق كثير من قومهم ، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون .
وعاد مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل الموسم التالي ، يحمل بشائر الخير ، ويخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- بما لقيه الإسلام في المدينة من قبول حسن ، وأنه سوف يرى في هذا الموسم ما تقر به عينه ، ويسر به فؤاده، فكانت هذه البيعة من أهم المنعطفات التاريخية في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم- وصحبه الكرام .
ومن خلال أحداث هذه المرحلة وما سبقها من عرض الإسلام على القبائل يمكن استخلاص العديد من الدلالات والمعاني المهمة ومنها :
الحكمة الربانية والتدبير الإلهي لهذا الدين في أن يكون الذين يستجيبون للرسول - صلى الله عليه وسلم- ويدافعون عنه وعن دينه ، من خارج قريش ، ومن غير أهله وعشيرته ، من أجل أن تقطع كل الشكوك حول طبيعة هذا الدعوة الجديدة ومصدرها وأهدافها ، ولئلا يقع أي التباس بينها وبين غيرها من الدعوات والمطامع الدنيوية .
ومن الدلالات أيضاً : أهمية وجود أرضية خصبة ، وسند قوي يحمي الدعوة ويحوطها ، ويحفظها من أن توأد في مهدها ، ولذا كان - صلى الله عليه وسلم- حريصاً على البحث عن قبيلة تسمح بنشر الدعوة بين ظهرانيها ، وتعلن حمايتها لها ، لأن الذين آمنوا به في مكة كانوا غرباء بين أقوامهم ، وكانوا نُزَّاعًا متفرقين في القبائل ، فكانوا بحاجة إلى ملاذ يفيؤون إليه ، وقبيلة تدفع عنهم وتحميهم ، وتمكنهم من نشر رسالتهم في العالمين ، وهو ما فعله - صلى الله عليه وسلم- .
ومن دلالات هذه البيعة ودروسها أن اختيار الرسول - صلى الله عليه وسلم- للمدينة وأهلها ، لحمل الرسالة ، ونيل شرف النصرة ، لم يكن اعتباطاً ، وإنما وقع الاختيار عليها لأن المدينة كانت تعيش ظروفًا خاصة رشحتها لاحتضان دعوة الإسلام ، فقد كان التطاحن والتشاحن بين الأوس والخزرج على أشده حتى قامت بينهم الحروب الطاحنة ، التي أنهكت قواهم ، وأوهنت عزائمهم ، كيوم بعاث وغيره ، مما جعلهم يتطلعون إلى أي دعوة جديدة تكون سببًا لوضع الحروب والمشاكل فيما بينهم ، ويمكن أن نلحظ ذلك من خلال قول أولئك النفر الستة : " إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم ، فندعوهم إلى أمرك ، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك " .
كما أن هذا الحروب كانت قد أفنت كبار زعمائهم وقادتهم ، ممن كان نظراؤهم في مكة والطائف وغيرهما حجر عثرة في سبيل الدعوة ، ولم يبق إلا القيادات الجديدة الشابة المستعدة لقبول الحق ، أضف إلى ذلك عدم وجود قيادة بارزة معروفة يتواضع الجميع على التسليم لها ، فكانوا بحاجة إلى من يأتلفون عليه ، ويلتئم شملهم تحت ظله .
ومن المعروف أن اليهود كانوا يسكنون المدينة مما جعل الأوس والخزرج على اطلاع بأمر الرسالات السماوية– بحكم الجوار- ، فكانوا اليهود يهددونهم بنبي قد أظل زمانه ، ويزعمون أنهم سيتبعونه ، ويقتلونهم به قتل عاد وإرم ، ولذا فبمجرد أن وصلت الدعوة إليهم ، قال بعضهم لبعض : " تعلمون والله يا قوم ، إنه للنبى الذي توعدكم به يهود ، فلا تسبقنكم إليه " .
ومن الدلالات أيضاً : أهمية معرفة الداعية والمربي لخصائص الناس وشخصياتهم ، ومن يصلح منهم لهذه المهمة أو تلك ، ندرك ذلك من خلال حسن اختياره - صلى الله عليه وسلم- لمصعب بن عمير للقيام بمهمة الدعوة ، ونشر الإسلام في المدينة ، لما كان يمتاز به رضي الله عنه - بجانب حفظه لما نزل من القرآن - من لباقة ، وهدوء ، وحكمة وحسن خلق ، فضلاً عن قوة إيمانه ، وشدة حماسه للدين ، ولذلك نجح أيما نجاح في دعوته ، واستطاع أن يتخطى الصعاب والعقبات الكثيرة التي واجهته باعتباره أولاً نازحاً وغريباً ، وثانياً يحمل رسالة جديدة تخالف ما عليه الناس ، وتريد أن تنقلهم من موروثاتهم التي ألِِفُوها ، وألْفَوا عليها آباءهم وأجدادهم ، ولعل في قصة إسلام سعد بن معاذ ، و أسيد بن حضير ما يبين ذلك بجلاء .
وهكذا مهدت هذه البيعة لما بعدها من الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ ، وكانت إيذاناً بأن عهد الذل والاستضعاف قد ولى إلى غير رجعة ، وسيكون بعدها للإسلام قوته ومنعته ، ، وستتوالى على مكة مواكب الخير ، وطلائع الهدى والنور التي هيأها الله لحمل رسالته ، وتبيلغ دعوته ، والعاقبة للمتقين .


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج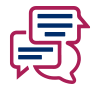 استشارات الحج
استشارات الحج

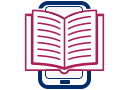












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات