
احتقنَ وجه المذيعة الألمانيّة، وأغلقت التسجيل سريعًا، وقالت لي: "آسفة جدًا، لا أستطيع أن أتركك تستمر". كنت وقتها أضرب مثلًا سريعًا، ينطوي على انتقاد الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية، في معرض حديث عن الفرق بين "العزلة المادية"، كما في حال إسرائيل وجنوب أفريقيا، و"العزلة الشعوريّة" التي تحدث عنها سيد قطب، و"العزلة النفسية" التي تصيب مرضى الاكتئاب أو التوحديين الغارقين في العزلة والانطواء.
قلت لها يومها – وكان الحديث لصالح الإذاعة الألمانية باللغة العربية على هامش ندوة عقدت في مدينة إيرفورت- : أتعجب من إغلاقك التسجيل، أين حرية التعبير التي تتحدثون عنها ليل نهار؟ أجابت على الفور: "إلا في هذا، فمجرد سماعي كلامك دون اعتراض قد يكلفني وظيفتي، وقد يتسبّب في مساءلتك هنا".
عقدة تاريخية
قهقهتُ، وسألتها: هل هذا مقبول بالنسبة لك؟ تلفتت حولها لتتأكد أن لا أحد يسمعها، وقالت: "أنا ضد هذا. إنه قيد شديد، لا مبرر له. نعم أنا أرفض بشدة الفظائع التي ارتكبها أودلف هتلر في حق اليهود، لكن لا أجد أي معنى أن يكون من حقي انتقاد الحكومة الألمانية بأقسى العبارات، بينما أمنع من مجرد إبداء أدنى ملاحظة على سياسة دولة أخرى".
قلت لها يومها: نحن في الشرق لا نرفض الهولوكوست فقط، بل نثمن ما قام به أجدادنا لحماية اليهود في بلادنا، والهاربين معهم من بلادكم؛ فرارًا من هتلر حين جاءت الجيوش الألمانية إلى شمال أفريقيا غازية، لكننا نتساءل متعجبين عن إلقاء أوروبا بأوزارها علينا، متخلصة من قسوتها التاريخية على اليهود، وحبسهم في غيتوهات تغلق عليهم عند حلول المساء، في وقت كانوا ممكّنين في الشرق، في الاقتصاد والثقافة والسياسة والمجتمع.
هزّت رأسها، وكرّرت أسفها عما جرى، وقالت: "أرجو أن تتفهم هذا، ولا أدري ربما يأتي يوم ونراجع فيه الموقف كله، ولا تستمر الأجيال تحمل عقدة ذنب جريمة ارتكبها النازي، الذي تُحارب أفكاره في ألمانيا".، ولم يكن هناك ما أفعله أمام ذعرها، وإبداء رفضها المكتوم لهذا، سوى تفهّم موقفها، أو بمعنى أدقّ الإشفاق عليها، ومواصلة الحديث بعيدًا عن ذكر إسرائيل.
تذكّرت هذا الحوار وأنا أرى اليوم الجامعات الأميركية تنتفض لنصرة قضية فلسطين، بل تتسع انتفاضتها نصرة للحرية في العموم. فالقمع الذي يقابل به كل من يعترض على سياسات إسرائيل يأتي بنتائج عكسية، بل يفتح أيضًا أذهان الطلاب اللامبالين أو المحايدين أو غير المشغولين بالسياسة وتصاريفها: لماذا في بلد حرّ يُمنع الناس من حرية الكلام في قضية ما؟
اختبار حقيقي
إن الطلاب الغاضبين في كثير من هذه الجامعات يزاوجون بين حريتهم وحرية الشعب الفلسطيني، وبين أمنهم وأمن هذا الشعب. فهم في الوقت الذي يرفضون "الإبادة الجماعية" لأهل غزة، وفق ما انتهت إليه محكمة العدل الدولية، ويرفضون استثمار الولايات المتحدة في إٍسرائيل، خصوصًا في الصناعات العسكرية، يطالبون بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، وينادون بالامتثال للدستور الأميركي الذي يقرّ الحرية في التعبير، دون مواربة، ويتعجبون من اتهامهم بـ "معاداة السامية" لمجرد أنّهم يرفعون أصواتهم ضد القتل والتدمير.
هكذا أتاحت القضية الفلسطينية للطلاب الأميركيين، وفي بلدان غربية عدة، أن يضعوا حريتهم النظرية محل اختبار حقيقي في الواقع المعيش، ويضعوا الافتراض الذي سبق أن طرحه جون ماشايمر، وستيفن والت – وهما أكاديميان أميركيان مرموقان قبل عشرين عامًا تقريبًا – عن تحول إسرائيل إلى عبء على الولايات المتحدة محلَّ تفكير. بل يمتد هذا الاختبار إلى ما يخصّ حالة الديمقراطية في المجتمع الأميركي نفسه، ومدى صلاحية بعض الأفكار الكبرى للتطبيق الآن.
إن هذا يعيد إلى الأذهان ما سبق أن جرى في فرنسا، حيث هتف الطلاب الغاضبون في المظاهرات التي اجتاحت البلاد في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من عام 1968: " فلتسقط البنيوية"، جنبًا إلى جنب مع شعار "يسقط ديغول"، باعتبارها سجنًا من اللغة، جدرانه من الأنساق والأنظمة، ولأنها، في نظرهم، تجعل الإنسان غريبًا أو مغتربًا بين هذه الجدران أو التحكّمات.
رحل ديغول بالفعل، وخلع كثير من البنيويين أرديتهم، وتحطم النسق المنغلق التسلطي، المنطوي على مركز ثابت كالعلة الأولى، لتطل برأسها مناهج ونظريات واقترابات أخرى. وراجع بعض البنيويين – مثل رولان بارت وألتوسير – أفكارهم، وانضم إليهم آخرون، لتبدأ مرحلة ما بعد البنيوية، وهي مدرسة فكرية رفضت إصرار البنيوية على الأطر والهياكل كمسار إلى الحقيقة، والتعامل مع اللغة على أنها نظام مغلق، وانطلقت من أن المعنى غير مستقر، وأن وجود فجوة بين الدال والمدلول، مسألة حتمية، وجعلت القارئ هو الأهم وليس الكاتب، ودرست كلًا من النص وأنظمة المعرفة التي أنتجته، متجلية في التفكيكية، ونظريات ما بعد الحداثة.
كسر القيود
لم تنتهِ عوارف البنيوية تمامًا، إنما تم تطويرها وتحسينها، فكل ما بعدها لا يستبعد عطاءها المهم في تحليل النص من داخله، أو إعطاء اللغة وزنها في التحليل. وعلى المنوال نفسه ليس من المنتظر أن تنتهي الأفكار التقليدية التي عششت في الذهن الاجتماعي الأميركي طويلًا حول "تقديس إسرائيل"، فبعضها يستند إلى نصوص دينية وتأويلات ومصالح اقتصادية واسعة، لكن بعضها سيكون محل مساءلة كما كانت البنيوية في فرنسا.
إن ما يفعله طلاب الجامعات في الولايات المتحدة، ليس هذا بالقليل، فكثير من التغيرات التي يشهدها الرأي العام، لاسيما في الدول الديمقراطية، يبدأ بطرح الأسئلة، واختبار صحة الافتراضات من عدمها. ومن ثم، وبمرور الوقت سيكسر الشباب في الغرب القيود التي تكبّل المواطن هناك حول إسرائيل، والتي تم فرضها عقودًا من الزمن، وتفهموها أو سكتوا عنها، أو لم يعنوا بها من قبل، ولم يفكّروا يومًا في أن يضعوها محل اختبار جادّ وحاسم.
لا يبدو الأمر سهلًا وإلا ما كان أثار مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصفَ احتجاجات الطلاب الأميركيين ضد إسرائيل بأنها "عمل مروع"، وطالب، في كلمة مسجلة له، ببذل مزيد من الجهد للتصدي له، قائلًا: "هذا عمل غير معقول، ويتعين وقفه وإدانته على نحو لا لبس فيه"، فيما يقول أكاديميون يهود مؤيدون لإسرائيل وأساتذة زائرون من إسرائيل نفسها؛ إن الاحتجاجات حولت الجامعات إلى "بيئة معادية لهم، يشعرون فيها بالخطر".
تحول مهم
تحدث نتنياهو أيضًا عن تصاعد "معاداة السامية" لكن اشتراك يهود في الاحتجاجات من بينهم أعضاء في جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، يتخذ نقطة ارتكاز للرد على هذا الاتهام، بل يجعل الطلاب يفكرون جادين في هذه المسألة، التي كانوا يسلمون بها في الماضي دون نقاش، ويمكن لقول نتنياهو أن يزيدهم إصرارًا على مواصلة ما هم فيه.
إن هذا يمثل تحولًا مهمًا، ينمو شيئًا فشيئًا، نازعًا عن إسرائيل الكثير من التعاطف معها الذي استمرّ عقودًا، وكاشفًا عن وجهها الحقيقي الذي كان الإعلام ومؤسسات التعليم في الغرب يخفيانه طويلًا تحت طبقة سميكة من مساحيق الدعاية والتلوين السياسي الفجّ.
وما أدرانا لعل عدوى الجامعات في أميركا تنتقل إلى أوروبا، ومنها ألمانيا، وألا تضطر هذه الصحفية العاملة في الإذاعة الألمانية – أو زميلة أخرى لها تأتي بعد سنين، – مذعورةً وآسفةً في آن لقطع حديث ضيفها بمجرد أن يأتي على ذكر إسرائيل، ولو بشكل عارض.


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج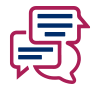 استشارات الحج
استشارات الحج

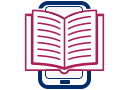












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات