
تعدُّ عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة بـ (بنت الشاطئ) حفيدة لأجداد من علماء الأزهر؛ فقد كان جدها لأمها شيخاً بالأزهر الشريف، تلقت تعليمها الأول في كُتَّاب قريتها، فحفظت القرآن الكريم كاملاً، والتحقت بمراحل التعليم الأولى، وأتمت دراستها الجامعية، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة العربية (1939م).
وقد أوصلتها دراساتها الأدبية إلى أن الدارسين اتجهوا إلى نصوص مختارة من شعر العربية ونثرها، وضعتها بين أيدي القراء، واشتغلت الجمهرة منهم بالمعلقات والنقائض والمفضليات ومشهور الخمريات والحماسيات والمراثي والمدائح والغزليات، ومأثور الرسائل والأمالي والمقامات، شُغلت بهذا ومثله عن القرآن الكريم الذي لا جدال في أنه كتاب العربية الأكبر، ومعجزتها البيانية الخالدة، ومثلها العالي الذي يجب أن يتصل به كل مسلم أراد أن يكسب ذوقها ويدرك حسها ومزاجها، ويستشف أسرارها في البيان وخصائصها في التعبير والأداء.
ومن ثَمَّ عكفت في أثناء تدريسها في عدد من الجامعات العربية على تحرير جملة من الدراسات القرآنية، توجتها بكتابها الموسوم (التفسير البياني للقرآن) حيث أمضيت سنين عاكفة على تدبر أسراره، ولمح إعجازه البياني، فجاء تفسيرها هذا -بحسب بعض الباحثين- من خيرة الجهود الحديثة التي بذلت في تفسير الكتاب العزيز.
جاء في مقدمة عملها أنها بحكم نشأتها في بيت علم ودين، أَلِفَتْ منذ صغرها أن تصغي بكل وجدانها إلى هذا القرآن، وأن تتلو آياته في تأثر وخشوع، لكنها لم تعِ بيانه حق الوعي، إلا بعد تخصصها في دراسة النصوص، واتصالها بأصيل ما للعربية من تراث أدبي، فكانت كلما ازدادت تعمقاً في الدرس، وفقه العربية، وقفت مبهورة أمام جلال هذا النص المحكم، وعادت تتلو من معجز آياته ما أدركت معه لماذا أعيا العرب -وهم فرسان الفن القولي، واللغة طوع لسانهم- أن يأتوا بسورة من مثله، فآمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما تلا فيهم آيات القرآن معجزة نبوته وآية رسالته، وإنه لبشر مثلهم، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.
ووفق المؤلِّفة فإن المنهج المتبع في درس التفسير كان تقليديًّا أثريًّا، لا يتجاوز فهم النص القرآني على نحو ما كان يفعل المفسرون من قديم، حتى جاء الشيخ أمين الخولي فخرج به عن ذلك النمط التقليدي، وتناوله نصًّا لغويًّا بيانيًّا على منهج أصَّله، وتلقاه عنه تلامذته، وهي منهم. وبحسب المؤلفة فإنه قليل من أساتذة العربية في الجامعات من حاول أن يجعل من النص القرآني موضوعاً لدراسة منهجية، على غرار ما فعلوا بنصوص أخرى لا سبيل إلى مقارنتها بالقرآن الكريم في إعجازه البياني. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدراسات القرآنية، في المجال العام، كانت تسير على غير منهج، وتصدى لها من المؤلفين من ليسوا أهلاً لها.
ونظراً لطبيعة تخصصها بالدراسات الأدبية فقد تبنت في تفسيرها منهجاً يقوم على فهم مفردات القرآن وأساليبه فهماً يعتمد على الدرس الأدبي الدقيق المدرك لأقصى ما يستطيع من إيحاء التعبير. وذكرت في مقدمة تفسيرها أن عملها ليس إلا محاولة لفهم النص القرآني فهماً مستشفاً روح العربية ومزاجها، مستأنسة في كل لفظ، بل في كل حركة ونبرة، بأسلوب القرآن نفسه، ومحتكمة إليه وحده، عندما يشتجر الخلاف، على هدى التتبع الدقيق لمعجم ألفاظه، والتدبر الواعي لدلالة سياقه، والإصغاء المتأمل، إلى إيحاء التعبير في البيان المعجز.
وقد صرحت بمنهجها في مقدمة تفسيرها، وهو منهج يقوم على استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده، للوصول إلى دلالته، وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل نظائرها في الكتاب المحكم، وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة، ثم سياقها العام في المصحف كله، التماساً لسرها البياني. وقررت في هذا الصدد أن القول بدلالة خاصة للكلمة القرآنية، لا يعني تخطئة سائر الدلالات المعجمية، كما أن إيثار القرآن لصيغة بعينها، لا يعني تخطئه سواها من الصيغ في فصحى العربية، بل يعني أننا نقدر أن لهذا القرآن معجمه الخاص وبيانه المعجز، فنقول إن هذه الصيغة أو الدلالة قرآنية، ثم لا يُعترض بأن العربية تعرف صيغاً ودلالات أخرى للكلمة.
والأمر كذلك فيما يهدى إليه الاستقراء من وجوه بيانية وظواهر أسلوبية، فهي تقدمها دون أن نخشى فيها مخالفة لبعض قواعد النحويين وأحكام البلاغيين؛ لأن الأصل أن تُعرض قواعدهم وأحكامهم على البيان القرآني، لا أن نعرض القرآن عليها ونخضعه لها. ومن هنا فهي ترى أننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في قواعد النحو وأحكام الصنعة البلاغية، في ضوء ما هدى ويهدي إليه التدبر الاستقرائي لكتاب العربية الأكبر في بيانه المعجز.
وهي بعملها هذا تنتفع بجهود المفسرين المتقدمين، فتعرض أقوالهم على القرآن الكريم، فتقبل منها ما يحتمله نصاً وسياقاً. ثم يكون إيرادها للأقوال الأخرى التي لا يقبلها النص، لفتاً إلى وجه الشطط فيها أو التكلف والاعتساف، وتنبيهاً إلى ما ينبغي من حذر وحرص، لاتقاء التورط في مقحم التأويلات المذهبية والمدسوسات الإسرائيلية. وهي إذ تضع معاجم العربية وكتب التفسير في خدمة منهجها، فإنها بعملها هذا تحاول أن تدرك حسن العربية للألفاظ التي تتدبرها من النص القرآني، عن طريق لمح الدلالة المشتركة في شتى وجوه استعمالها لكل لفظ.
وعلى الرغم من غنى المكتبة القرآنية بكتب التفسير، بحيث لا يجرؤ منصف على أن يجحد فضل جهود المفسرين في تفسير كتاب الله، فهم الذين بذلوا في خدمة القرآن جهوداً جليلة، وتركوا آثارهم زاداً لمن بعدهم، بيد أن التفسير ظل -باعترافهم- من علوم العربية التي لم تنضج بعدُ ولم تحترق، وهذا الاعتراف دفع بالمؤلفة لتقتحم هذا الميدان الجليل في حدود جهدها وطاقتها واختصاصها، كما شفع لها -أحياناً- أن ترفض بعض أقوال لهم وتأويلات واتجاهات، قد رأتها -من وجهة نظرها- بعيدة عن روح العربية الأصلية، ومجافية نصًّا وروحاً لبيان القرآن المحكم.
وقررت بخصوص المنهج مسألتين:
أولاهما: أن المرويات في أسباب النزول موضع اعتبار في فهم الظروف التي لابست نزول الآية، مع تقدير أن الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا نزولها ورويت عنهم أقوال فيها، وربطها كل منهم لما وهم أو فهم أنه السبب في نزولها. وهذا هو معنى قول علماء القرآن: إن المرويات في أسباب النزول يكثر فيها الوهم، ومن ثم فإن السببية فيها ليست بمعنى العلية التي لولاها ما نزلت الآية، بل العبرة في كل حال بعموم اللفظ المفهوم من صريح نصها، إلا أن يتعين الاعتبار بخصوص السبب الذي نزلت فيه بدليل من صريح النص أو بقرينة بينة.
والأخرى: أن ترتيب النزول موضع اعتبار كذلك، لفهم السياق العام لما نتدبر من آيات القرآن ودلالات ألفاظه وخصائص بيانه في المصحف كله {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء:82).
وبحسب المؤلفة، فإن الأصل في منهج عملها هو التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه، فيجمع كل ما في القرآن منه، ويهتدى بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب، بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذاك، وهو منهج يختلف والطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة، يؤخذ اللفظ أو الآية فيه، مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كله، مما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه، أو لمح ظواهره الأسلوبية وخصائصه البيانية.
وقد طبَّقت المؤلفة منهجها في تفسير بعض قصار السور، وقصدت يهذا الاتجاه توضيح الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسير، ومنهجها الاستقرائي الذي يتناول النص القرآني في وجهه الإعجازي، ويقدر حرمة كلماته بأدق ما عرفت مناهج النصوص من ضوابط، ويلتزم دائماً مقولة السلف الصالح: "القرآن يفسر بعضه بعضاً" -وقد قالها المفسرون ثم لم يبلغوا منها مبلغاً- ويحرر مفهومه من العناصر الدخيلة والشوائب المقحمة على أصالته البيانية. وهذا المنهج -بحسب المؤلفة- يعدُّ مطلباً أساساً لا بد لمن يتصدى للقرآن الكريم بتفسير أو إيضاح.
وكان من منهجها -أيضاً- أنها ركَّزت على الجانب الدلالي لألفاظ القرآن فيما اسمته بـ (الإعجاز البياني للقرآن)، والذي ينصبُّ على بيان وجه الإعجاز القرآني في اختيار اللفظ دون غيره من المترادفات الأخرى في التعبير عن معنى محدد؛ فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الكلمتين المترادفتين: (رؤيا)، و(حلم)، نجد أن القرآن الكريم جاء بكل واحدة منهما في سياق لتعبر عن معنى معين، فأوضحت أن استخدام كلمة (الرؤيا) قد جاء في سياق معين، بحيث لا يمكن أن تحل محلها كلمة (الحلم)، وقد تبين من السياق القرآني أن كلمة (رؤيا) ترتبط بالتصديق، وتتسم بالوضوح، مثلما جاء في قوله تعالى: {إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين * قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين} (يوسف: 4-5). وكذلك الأمر في رؤيا ملك مصر: {وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون} (يوسف:43). أما كلمة (الحلم) فتأتي في صيغة الجمع، وتدل على التداخل وعدم الوضوح، تبين ذلك في رد الملأ على طلب ملك مصر بتفسير رؤياه: {قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين} (يوسف:44). هكذا يبدو الإعجاز البياني للقرآن الكريم في استخدام المترادفات، فكل لفظ يؤدى معنى معين لا يمكن للفظ المرادف له أن يؤدى المعنى نفسه. وقد تعرضت المؤلفة لعدد من النماذج لهذا الإعجاز، فقدمت بعملها هذا إضافة جديدة وجديرة بالتسجيل في مجال تفسير القرآن.
وقد أكدت المؤلفة أن الدراسة المنهجية لنص القرآن الكريم، يجب أن تتقدم كل دراسة أخرى فيه، لا لأنه كتاب العربية الأكبر فحسب، ولكن لأن الذين يعنون بدراسة نواح أخرى فيه، والتماس مقاصد بعينها منه؛ لا يستطيعون أن يبلغوا من تلك المقاصد شيئاً دون أن يفقهوا أسلوبه ويهتدوا إلى أسراره البيانية التي تعين على إدراك دلالاته. فسواء أكان الدارس يريد أن يستخرج من القرآن أحكامه الفقهية، أو يستبين موقفه من القضايا الاجتماعية أو اللغوية أو البلاغية، أم كان يريد أن يفسر آيات الذكر الحكيم على النحو الذي ألفناه في كتب التفسير، فهو مطالب بأن يتهيأ أولاً لما يريد، ويعد لمقصده عدته: من فهم مفردات القرآن وأساليبه، فهماً يقوم على الدرس المنهجي الاستقرائي، ولمح أسراره في التعبير.
ومن ثَمَّ سيرى المتخصصون في الدراسة القرآنية -بيانية أو فقهية- مدى حاجتنا إلى فهم نصه قبل أي شيء آخر، وسيرون كذلك ما تكشف عنه المحاولة من شطط التأول في كثير من كتب التفسير واللغة والبلاغة، أو من بعد التكلف واعتساف الملحظ، وتحميل ألفاظ القرآن وعباراته ما يأباه القرآن نفسه حين نحتكم إليه.
وقد أشارت المؤلفة في مقدمة تفسيرها إلى أمر ذي بال وهو أن كل من له اتصال بالدراسات القرآنية، يعرف ما حشيت به كتب التفسير من إسرائيليات حاول بها يهود، ممن دخلوا في الإسلام طوعاً أو نفاقاً، تطعيم فهم المسلمين لكتابهم الديني بعناصر إسرائيلية. إضافة إلى شوائب أخرى جاءت نتيجة لتباين أذواق المفسرين وعقلياتهم وبيئاتهم وأنماط شخصياتهم، في ذلك العالم الواسع العريض الذي امتد من الصين والهند في أقصى المشرق، إلى مراكش والأندلس في أقصى المغرب، وتقاسمته ألوان من عصبيات مذهبية وسياسية وطائفية، فاقتضى هذا بطبيعة الحال أن تواردت على كتاب الإسلام أمم وطوائف شتى، تتذوقه متأثرة بظروفها الخاصة، ويفسره المفسرون منهم تفسيراً يوجه النص توجيهاً يعوزه في كثير من الأحايين، ذوق العربية النقي ومزاجها الأصيل؛ وقد ينحرف به عن وجهته ضلال التعصب أو خطأ المنهج أو قصور التناول.
يشار أخيراً إلى أن المؤلِّفة لم تضع تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم، بل اقتصر عملها على بعض قصار سوره؛ ملحوظ فيها وحدة الموضوع، وأكثرها من السور المكية، حيت العناية بالأصول الكبرى للدعوة الإسلامية، فتضمن الجزء الأول السور الآتية: النازعات، البلد، الضحى، الشرح، الزلزلة، العاديات، التكاثر، في حين تضمن الجزء الثاني سور: القلم، الفجر، العلق، الليل، العصر، الهمزة، الماعون.
وفي ختام مقدمتها قرَّرت المؤلِّفة أن الباب يظل مفتوحاً لجهد أجيال من العلماء تتعاقب على تدبر الكتاب المجيد، فتدرك منه ما فاتها أن تدركه، وتستشرف لآفاق قصرت محاولتها عن مدادها.


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج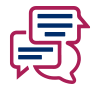 استشارات الحج
استشارات الحج

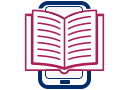












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات