
جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال له: (... واعلم أن الأُمة لو اجتمعت على أَن ينفعـوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف)(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح).
وهذا الكلام كله كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها ـ ليس الآن ـ ولكن منذ أمد بعيد، لأن الصحف إنما تجف ـ أو بالأحرى يجف المداد الذي كتبت به ـ إذا فرغ من الكتابة وارتفعت الأقلام عنها مدة.
وقد دلت آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه أفضل صلاة وتسليم على أن الله قدر مقادير العباد قبل أن يخلقهم بآلاف السنين، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة).
فكل ما يجري في هذه الحياة إنما هو قدر الله الذي قدره على العباد بعلمه فيهم.. فأمر القلم بكتابته فهو مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، وهو نافذ في الخلق بقدرة الله وإرادته التي لا تغلبها إرادة المخلوقين {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين}(التكوير:29)، {وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة}(المدثر:56).
وآيات القرآن دالة على أن كل ما يقع في هذا العالم وكل ما يصيب الخلق إنما هو مكتوب مسطور؛ قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}(الحديد:22).. وقال: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}(التوبة:51).
وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أولَ ما خلق اللهُ القلمُ، فقال لهُ: اكتبْ، قال: ربِّ وماذا أكتبُ؟ قال: اكتُبْ مقاديرَ كلِّ شيءٍ حتى تقومَ الساعةُ)(صحيح أبي داود).
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: (جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يارسول اللهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأنَّا خُلِقْنَا الآنَ، فِيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير، قالَ: فَفِيمَ العَمَلُ؟ قالَ زُهَيْرٌ: ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو الزُّبَيْرِ بشيءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَسَأَلْتُ: ما قالَ؟ فَقالَ: اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ).
والأحاديث في ذلك كثيرة يطول ذكرها.. خلاصتها ما قاله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: (جفّ القلمُ بما هو كائن، فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيءٍ لم يقْضِه اللهُ تعالَى لم يقدِروا عليه وإن أرادوا أن يضُرُّوك بشيء لم يكتُبْه اللهُ عليك لم يقدِروا عليه)(قال الصنعاني في سبل السلام: إسناده حسن).
وهذه الكلمات هي حقيقة الإيمان، ومن حققها وامتلأ بها قلبه فقد عرف حقيقة الإيمان؛ كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال: (إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه)(انظر صحيح الجامع2150).
وقد وصى بذلك عبادة بن الصامت ابنه فقال: "واعلم يا بني أنك لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك".
ومدار وصية النبي لابن عباس يدور حول هذا الأصل، وكل ما ذكر قبله فإنما هو متفرع منه وراجع إليه؛ لأن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أوشر أو نفع أو ضر، وأن الناس لا يملكون له شيئا قليلا أو كثيرا، وأن اجتهادهم على خلاف المقدور غير نافع البتة، علم أن الله هو الضار النافع المعطي المانع، المعز المذل، المانح المانع، وأنه وحده المتفرد بالتصرف في الكون ولا ينفذ فيه إلا أمره، فعندئذ يفرده بالعبادة، ويسلم له قلبه، ويخلص له في الطاعة طلبا لرضاه واستجلابا للخير والنفع منه، إذا لا يأتي بالنفع إلا هو ولا يدفع الضر سواه.
ولذلك نعى الله على من يشرك به أو يعبد معه غيره، أو يدعوه أو يرجوه، وهو لا يغني عنه شيئا؛ كما قال إبراهيم الخليل لأبيه: {يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا}(مريم:42).. وقال سبحانه: {إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين}(الأعراف:194).. وقال: {ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا}(الفرقان:55).. وقال: {قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون}(الزمر:38).
فإذا عرفت هذا واستيقن به قلبك ـ وعلمت أن الناس لو اجتمعوا على أن يغيروا فيك مواضع القدر لم يستطيعوا لا أن ينفعوك بشيء ولا أن يضروك بشيء إلا ما كتبه الله، ولا أن يزيدوا في عمرك نفسا أو في رزقك درهما أو ينقصوا إلا ما قدره الله ـ أكسبك ذلك أمرين عظيمين:
الأول: الرضا عن الله في قضائه.. وإلا فالصبر.. والثاني: حسن التوكل عليه سبحانه.
فأما الرضا:
فهو باب الله الأعظم وجنة الدنيا، ومستراح العابدين. وهو تارة يكون بملاحظة حكمة المبتلي، أو بانتظار الثواب وعظمته، أو بملاحظة عظمة الله وجلاله وكماله والاستغراق في ذلك حتى ربما ينسى العبد ألم البلاء فلا يشعر به.. قال تعالى: {ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه}(التغابن:11).. قال قتادة: "هي المصيبة تصيب المؤمن يعلم أنها من الله فيسلم لها ويرضى".
وروى الترمذي عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط)(حديث حسن وهو في السلسة الصحيحة).
ولقي علي بن أبي طالب عدي بن حاتم، فوجده مهموما فقال له: "يا عدي من رضي بقضاء الله مضى عليه وكان له أجر، ومن لم يرض بقضاء الله مضى عليه وحبط عمله".
ففي الرضا الفرح والراحة، وفي السخط الحزن والهم.. قال ابن مسعود: "إن الله بقسطه وعدله جعل الروح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، "..
فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة رضاه عن الله وقضائه، وشدة علمه برحمة الله بعباده المؤمنين، ولذلك لما دخلوا على بعض التابعين في مرضه فسألوه عن حاله قال: "أحبه إليَّ أحبه إليه". يعني أحب ما يحبه لي، وأرضى بقضائه في، وحسن اختياره لي.
قال عمر بن عبد العزيز: "أصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر".
وإنما يحمل المؤمن على الرضا بمواضع القدر هذا اليقين والفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم السابق، وأيضا ما بشر النبي به الراضين كما في صحيح مسلم: (لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له).
فمن رضي عن الله عاش سعيدا ومات سعيدا وحشر يوم القيامة مع السعداء.. قال تعالى: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة}(النحل:97).. قال المفسرون الحياة الطيبة الرضا والقناعة.
ثانيا: التوكل على الله
وهو دليل صحة إيمان العبد وصلاح قلبه، وهو اعتراف العبد بربوبية الله، وتسليمه كل أموره صغيرها وكبيرها للخالق الواحد الأحد.
قال سعيد بن جبير: "التوكل على الله جماع الإيمان"، وهو كما قال ابن القيم: "نصف الدين"..
وخلاصة القول فيه: "أنه صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والأخرة وكِلَةُ الأمور كلها إليه". قال ابن عباس: "التوكل هو الثقة بالله".. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: "هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق".
والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، ولهذا أمر الله به عباده فقال: {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين}(المائدة:23)، {وعلى الله فليتوكل المؤمنون}(التوبة:51)، {وعلى الله فليتوكل المتوكلون}(إبراهيم:12)، وأخبر أنه يحب أهله فقال: {فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين}(آل عمران:159).
وبالجملة فإن التوكل من أجمع أنواع العبادات، وأعلى مقامات التوحيد، فمن حققه وتوكل على الله حق توكله تولاه الله، ويسر أمره، وحقق مساعيه، ورزقه من حيث لا يحتسب: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه}.(سورة الطلاق:2-3).


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج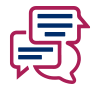 استشارات الحج
استشارات الحج

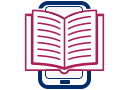












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات