
من مقتضى عالمية الرسول صلى الله عليه وسلم التي نص عليها القرآن (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) صلاحية رسالته للعالم كله، وإمكانية استصلاح أحوال هذا العالم برسالته، ومعالجة المشاكل كلها بالاهتداء بالنور الذي أرسل به، ولن نكون مغامرين بمثل هذا الكلام بالتنظير المجرد، بل إن دراسة التحولات الجذرية التي أحدثها في مجتمع العرب آنذاك، والتأمل في الفوارق بين مجتمع الجاهلية ومجتمع الإسلام، والتفكير الموضوعي في الصبغة التي صبغ بها أفكارهم، ومعتقداتهم، وحياتهم السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعسكرية، وغيرها دليل مادي على قدرة هذه الرسالة على استيعاب مشاكل الإنسان أيا كان موقعه الجغرافي، إذا أسلم وجهه لله، واتبع النور الذي جاء به هذا الرسول الأمين.
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر وغيره: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود». وفي رواية: «إلى الناس كافة».
ولما علم الله قابلية هذه الرسالة لمواجهة الحوادث المتجددة عبر القرون المتطاولة، جعلها عامة وكافة، فعموم المرسل إليهم يستلزم عموم الرسالة، وتضمنها للتعاليم المطلقة والمجردة عن كل قيود العنصرية والطبقية والجغرافية، فهي فوق كل تلك الاعتبارات الطردية التي لا أثر لها في التصنيف والتمييز، مما أكسبها القدرة على تجاوز العقبات، والتعاطي مع الأزمات بمعقولية متفردة.
وليس المقصود من الكلام أن نصوص السنة -التي هي مجال الدراسة- قد نصت على كل مشاكل العالم بمسمياتها، ومصطلحاتها القائمة في دنيا الناس عبر العصور المختلفة، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حلولا لمشاكل قائمة في زمنه بالنص، وحلولا لمشاكل قادمة من خلال الكليات العامة المستقاة من تلك النصوص، ومن خلال توجيه العقل المسلم نحو التطوير والاكتشاف، والاستفادة من التجارب البشرية ضمن دائرة الإسلام الواسعة، فهذا هو معنى أن الرسالة مستوعبة لمشاكل العالم، وتمتلك الحلول الناجعة لكل أحوال الإنسان في صورتها المركبة أو البسيطة، إذن فالشريعة عموما تمتلك الحلول والمعالجات إما بالنص أو بمعقول النص، ولا يزال العلماء قديما وحديثا يقايسون النوازل، ويلحقونها بنظائرها، من خلال المقاصد العامة، والعلل الجزئية، والاستصلاح الشرعي المنضبط.
وبالتالي فإن إدراك المنهج النبوي في التعامل مع المشكلات، والاستفادة من الحلول والمعالجات النبوية من الأهمية بمكان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه، وأقواله وأفعاله و تقاريره رافقها الوحي إقرارًا و تصحيحًا، فأساليبه – عليه السلام – أحكم و أنجح، واستعمالها أدعى لاستجابة الناس، واتباع المربي لهذه الأساليب والطرائق يجعل أمره سديدًا، وسلوكه في التربية مستقيما.
ولا يسع المقام لسرد مئات النصوص المتضمنة للحلول المباشرة التي يلمسها الإنسان ويرى تأثيرها بمجرد أن يمتثل الأمر، ولو طبق الناس الإسلام لرأوا كيف يصبح السلام واقعًا حقيقيًا لا خداع فيه ولا تجبر ولا مكائد ولا دسائس، وكيف أن جميع مشكلات العالم تذوب من تلقاء نفسها كما يذوب الملح في الماء؛ لأن الحلول الإسلامية تناجي كل قلب على حدة وتقول له: ابدأ بنفسك ليقتدي بك الآخرون، فتصبح الدعوة جماعية في آن واحد دون أن يتدخل أي شخص في تفكير الآخر.
وإبراز الحلول التي تزخر بها هذه الرسالة الخالدة من فروض العصر التي يجب أن يضطلع بها حملة الشريعة، سيما في وقت بات العالم في أتعس مراحل التيه، وأبعد دركات الضياع، وقد جربوا كل نتاج البشر، من الأطروحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والنظريات الأيدلوجية الموجهة، ولم يجدوا إلا مزيدا من الحروب والدمار، وركاما من التعقيدات والمشاكل الاقتصادية المتواصلة، وذاقوا نتاج الحرية المنفلتة من ضياع الأسرة، وتردي الشذوذ، وتزايد نسبة القتل والجريمة، وتنامي العصابات والمليشيات، ولم يبق إلا أن يأخذ الصادقون بمبادرات الدعوة إلى عدل الإسلام، فهو طوق النجاة، وإكسير الحياة الفاعل، ومن يتابع الأرقام اليومية لتلك الأرواح المهاجرة إلى رياض الإسلام ممن رأوا نوره، وأحسوا بعدالته، يدرك تماما أن هذا الإسلام قادر على إذابة هذا الجليد من المشكلات العالمية المختلفة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج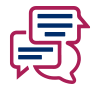 استشارات الحج
استشارات الحج

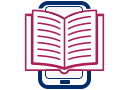












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات