
إذا فَقِه طالب العلم حقيقةَ ما يطلبه، ولأيِّ شيءٍ أعلى الله تعالى مقامَه أيقن أنه إلى علمٍ قليلٍ يستحثُّ جوارحَه للعمل وقلبَه إلى القرب من الله تعالى أحوجُ منه إلى كثيرٍ يُثقِلُ جوارحَه ويُبعِدُ فؤادَه، وقد قال مالكٌ من قبل: (لا أحبُّ الكلامَ إلا فيما تحتَه عمل، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام إلا فيما تحته عمل)[جامع بيان العلم وفضله2: 189].
ومدَّ حبلاً إلى العلوِّ فنقل عن القاسم بن محمد أنه قال: (أدركتُ الناسَ وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل)[السابق2: 17].
وهذا من تمامِ الفقه عن الله، وكمالِ رعاية العلم، فالعلم إنما شَرُف لشَرَفِ ثمرته العملية القائمة بالقلب والجوارح، فإذا لم يؤد ثمرتَه المنوطةَ به انحلَّ شرفُه وارتفع عنه فضلُه.
بل زاد من تدقيق السلف لهذه المقامات أنْ جعلوا من العلمِ مهرباً للعاطلين عن العمل! وذلك أن الحسنَ البصريَّ رحمه الله دخل المسجد يوماً، فقعد إلى جوار حلقة يتكلمون، فأنصتَ لحديثهم، ثم قال: (واللهِ ما هؤلاء إلا قومٌ ملُّوا العبادة، ووجدوا الكلامَ أهونَ عليهم، وقلَّ ورعُهم وتكلَّموا)[حلية الأولياء 1: 156].
فالبدء بفرض القلب وواجب الروح فرضُ طالب العلم وواجبُه، وتعرُّفُ سلوك الطريق وقطعُ عقبات القلب من أجلِّ أولوياته، ثم لينظر بعد ذلك فيما فيه صلاح العباد، وقد قال بعض السلف: (ما تعلمتُ العلم إلا لنفسي، وما تعلمتُه ليحتاج الناس إليَّ). فعقَّب مالكٌ على هذا القول مسلسِلاً هذا الصنيع كعادته في ضبط معالم الأمر الأول، فقال: (وكذلك كان الناس، لم يكونوا يتكلَّفون هذه الأشياء ولا يسألون عنها)[المدخل إلى السنن الكبرى].
طالبَ العلم .. لا يستخفنَّك كَمُّ المسائل عن كَيفِ القلب، وخُذْها من إمام الدنيا.
جرى ذكر معروف الكرخي في مجلس الإمام أحمد، فقال أحد الجلوس عن معروف: (قصير العلم).
ويلُمَّ ذا القائل.. ربَّما كان حديث العهد بمجلس أحمد!
انتهره أحمد وقال له: (أمسِكْ).. ولَكَأنَّما انسدلتْ أمام ناظرَي أحمدَ سيرةُ معروفٍ وزهدُه وورعُه وفَرَقُ قلبه من ربِّه، فشقَّ عليه أن يُلمَز في مجلسه بقصر العلم وقد كان من شأنه ما كان. ثم نطق بلسان الإمامة بعد تجربةٍ طويلةٍ مع العلم وأهله، تجربةٍ حدث عن طرفٍ منها بقوله: (سافرتُ في طلب العلم والسنة إلى الثغور، والشامات، والسواحل، والمغرب، والجزائر، ومكة، والمدينة، والحجاز، واليمن، والعراقين جميعاً، وأرض حوران، وفارس، وخراسان، والجبال، والأطراف).. وبعد ذلك كلِّه يقول: (وهل يُرادُ من العلم إلا ما وصل إليه معروف!)[سير أعلام النبلاء للذهبي 9: 340].
يا لله! ما قال رضي الله عنه: لم يكن قصير العلم، لعلمه أنَّ معروفاً لم يكن واسع العلم بالمعنى الذي يقصده اللامز، لكن ما هكذا يُقاس الرجال، ولا هكذا يُعايَرُ العلم، فأراد أن يقذف في روعه أن العلم لا يُقوَّمُ بطولٍ ولا قِصَر، ولا بضيقٍ واتَّساع، بل بما قام بالقلب من الإيمان واليقين، فقال بهذا الفقه تلك القَولةَ الخالدةَ الأسيفةَ: (وهل يُرادُ من العلم إلا ما وصل إليه معروف!).
وقد كان عَلَمُ الزهَّادِ أبو محفوظ معروفٌ الكرخيُّ على دراية بحقيقة العلم، ولذا سجَّل خلاصة مطالعاته في صحيفة الحياة بما انتهى إليه علمه من أحوال العلم وطلابه، فقال: (إذا أراد الله بعبدٍ شرّاً أغلق عنه باب العمل، وفتح عليه باب الجدل)[السابق].
وبهذا الفقه بلغ أنْ قال فيه إمام الدنيا أحمد بن حنبل ما قال، فعلمُ الطالب إن لم يتحرَّك بالعمل تحرَّكَ بالجدل والتباهي، ولا آفةَ أمحقُ بالعلم وبركته من أن يكون محلّاً للتباهي والجدل.
ثم يأتي ابن الجوزي ليقرِّرَ أن العلم وحدَه قاصرٌ عن إصلاح قلب الطالب، فيقيِّد خاطرُه أن (الاشتغالَ بالفقه وسماعَ الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يُمزَجَ بالرقائق والنظر في سير الصالحين)!
ولا تعجلْ باللائمة عليه، فليس مجرَّدَ خاطرٍ عابرٍ سَنَحَ له وقيَّده، بل الشأن كما قال: (وما أخبرتُك بهذا إلا بعد معالجة وذوق).
ويبيِّن كيف لا يكون ذلك كافياً في صلاح القلب، بل يتعجب أصلاً في تحقُّقِ صلاحه معه! فيقول: (لأني وجدت المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء. وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يُغالَبُ به الخصم. وكيف يَرِقُّ القلب مع هذه الأشياء؟)[صيد الخاطر:228].
كيف يرقُّ قلب طالب العلم وهو لا يشفع إلى علمه بالمسائل النظرية العلمَ بأحوال قلبه وما به صلاحُه، وهو إن اقتصر على النظريِّ من العلم فإنه بذلك قد نال علماً .. لكن لِيُوقنْ أن مثالَه (مثالُ من اقتصر من سلوك طريق الحج على علم خرز الرواية والخف، ولا شك في أنه لو لم يكنْ لتعطَّلَ الحج، ولكن المقتصر عليه ليس من الحج في شيء ولا بسبيله، فـ (في الناس من حَصَل له العلم، وغَفَل عن العمل بمقتضاه، وكأنَّه ما حصَّل شيئاً)[الإحياء للغزالي].
إنْ كان لطالب العلم همٌّ فليجمعه أولاً في همِّ صلاح القلب، وليبلُغْ تفكيرْه في ذلك مبلغَ أنفاسه، فإنه معيار صحة طلبه واستقامة قصده .. فيا ضيعةَ العمر إن كان العلم مجلبةً لقسوةٍ ينأى بها الطالب عن مدارج الخائفين!
أبو بكر القفال المروزي
أبو بكر القفال المروزي، جوهرة شافعية خراسان وإمامهم، لم يكن في زمانه أفقه منه، ولا يكون بعده كما يقرر الفقيه ناصر العُمَري، وكان يُقال عنه: مَلَكٌ في صورة إنسان!
تعلَّق بالعلم، وأجراه منه مجرى دمه، فلم يكن له اشتغالٌ بغيره، وزاد على ذلك أنه كان على فقهٍ تامٍّ بحقيقة العلم .. وخُذْها من سيرته.
تصدَّر كغيره من أئمة العلم لإفادة طلاب العلم، والجلوس لتفقيههم، غير أنَّ له حالاً قليلةَ التحقُّق في غيره، فقد كان في سياق درسه وهو يشرح مسائل العلم ويقيِّد عنه طلابُه فوائدَه يتوقَّف .. يتوقَّفُ لسانه عن الكلام، وتتولى عيناه مهمة المواصلة، لكن المواصلة حينئذٍ تكون بالدموع!
لا موعظةَ تمهِّد لهذه الدموع، لا موقفَ يستدعيها، لا مشهدَ يستدرُّها .. ولكنه قلب العالم حين يرتاض على خشية ربه فتأتيه الدموعُ على غير ميعاد.
ينقل القاضي حسين للعالمين هذا الموقف المتكرر المدهش، فيقول عنه: (كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء في الدرس).
وإذا ناله ذلك أطرق برأسه متفكِّراً، متأمِّلاً، وطلابُه ما بين مشاركٍ بالدمع ومراقبٍ بالعين، ثم تأتي ختمة الإطراق، فيرفع رأسه، ويستقبل بوجهه طلابَه، وعيناه تفيضُ من الدَّمع، ثم يقول: (ما أغفَلَنا عما يُرادُ بنا!).
ما الذي قام في قلبك أبا بكر حتى قلتَ ما قلت ؟
ما الذي أيقظ علمك بالخشية وجعل منه علماً لا كالذي نطلبه ؟
أي غفلة تلك التي أنبتت زفرة الأسى وأنت تتعبد الله في مجلس علم ؟!
أين السبيل أبا بكر لهذا الإطراق وذلك الدَّمع ؟
كثيرٌ من الحقائق مُرُّ المذاق، لكن لابدَّ من تجرُّعه: علمٌ لا يوصلُ إلى الله تعالى، ولا يوجبُ رقَّةَ القلب، ولا يُجرِي دمعَ العين من خشية الله تعالى، إن لم يَضُرَّ في الآخرة لم ينفعْ، وليس هو بالعلم الذي جاءت النصوص بالحثِّ عليه، ولا بالذي نال أهله درجة الوراثة من أنبياء الله ورسله.
يستطيل الزمان على طالب العلم والقلبُ هو القلب، إن لم يتأخَّر عما كان عليه!
لم تجر على وجنتيه دمعةٌ حين نظره في مسألة من مسائل العلم، ولا اقشعرَّ بدنه حين قلَّب النظر في نصوص الوحي محاولاً الاهتداء بدلائل القلب قبل دلائل اللسان.
يتذكَّرُ ذلك، ويتلمَّظُ من فرط حسرته، فيستحثُّ ذهنه لتأويلاتٍ مهدِّئة، من جنس أن العلم في حد ذاته عمل، والفضل للمتعدِّي، (ولولا نَفَر)، (وكلٌّ ميسَّر)، «وكلانا على خير» .. فيأتي بها وبأشباهها مكشوفة مفضوحة، يَقنَعُ بها عقلُه ويستحي من قبولها فؤادُه، والشأن كما قال الله: {إنَّما يخشى اللهَ من عباده العلماء}.. فإن لم تخشَ الله فانظر في هذا العلم الذي تطلبه، أيُّ علمٍ هو؟ فليس هو بالذي سأل نبيُّنا المزيدَ منه، ولا الذي بشَّر بأن الحيتان تستغفر لمعلِّمه، ولا الذي من سلك سبيله سهَّل الله له طريقاً إلى الجنة.
ـــــــــــــــــــــ
مجلة البيان


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج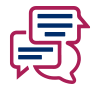 استشارات الحج
استشارات الحج

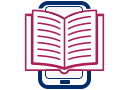












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات