
سورة الحجرات هي السورة التاسعة والأربعون بحسب ترتيب المصحف العثماني، وهي السورة الثامنة بعد المائة بحسب ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم، وكان نزولها سنة تسع للهجرة، وهي سورة مدنية باتفاق أهل التأويل، وعدد آياتها ثمان عشرة آية. وهي أول سور المفصَّل -بتشديد الصاد- على الأرجح من أقوال أهل العلم، ويسمى المحكم. والمفصل هو السور التي تستحب القراءة ببعضها في بعض الصلوات الخمس على ما هو مبين في كتب الفقه.
تسميتها
سميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير سورة الحجرات، وليس لها اسم غيره؛ ووجه تسميتها أنه ذُكِر فيها لفظ الحجرات، حيث نزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته، فعُرفت بهذه الإضافة.
وجه ارتباطها بما قبلها
ترتبط سورة الحجرات بسورة الفتح قبلها بعدة روابط، منها: أنهما مدنيتان ومشتملتان على أحكام، وأن سورة الفتح فيها قتال الكفار، وهذه فيها قتال البغاة، وتلك خُتمت بالذين آمنوا، وهذه افتتحت بالذين آمنوا، وتلك تشريفاً له صلى الله عليه وسلم وبخاصة مطلعها، وهذه تضمنت تشريفاً له في مطلعها، إلى غير ذلك.
مقاصدها
ذكر الفيروزآبادي أن "معظم مقصود السورة: محافظة أمر الحق تعالى، ومراعاة حُرْمة الأَكابر، والتُّؤدة في الأمور، واجتناب التَّهور، وإغاثة المظلوم، والاحتراز عن السخرية بالخَلْق، والحذر عن التجسس والغيبة، وترك الفخر بالأحساب والأنساب، والتحاشي عن المنَّة على الله بالطاعة، وإحالة علم الغيب إِلى الله تعالى".
ورأى ابن عاشور أن السورة تضمنت المقاصد التالية:
أولاً: تعليم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وخطابه وندائه، دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم من جفاء الأعراب، لما نادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بيوته.
ثانياً: وجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به.
ثالثاً: التثبت في نقل الخبر مطلقاً، وأن ذلك من خلق المؤمنين، ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين والمنافقين.
رابعاً: الحث على الإصلاح بين المسلمين؛ لأنهم إخوة.
خامساً: الحث على حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالهم الظاهرة والباطنة.
سادساً: التحذير من بقايا خُلق الكفر في بعض جفاة الأعراب.
وقد قال الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (الحجرات: 6) قال: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله، أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مع غيرهما من أبناء الجنس، وهم على صنفين: إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة، أو خارجين عنها، وهم أهل الفسق، والداخل في طائفتهم: إما أن يكون حاضراً عندهم، أو غائباً عنهم، فهذه خمسة أقسام، قال: فذكر الله في هذه السورة خمس مرات: {يا أيها الذين آمنوا} وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة.
وذكر سيد قطب رحمه الله أن هذه السورة مع أن آياتها لا تتجاوز الثماني عشرة آية، إلا أنها تضمنت حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة، ومن حقائق الوجود والإنسانية. حقائق تفتح للقلب وللعقل آفاقاً عالية، وآماداً بعيدة، وتثير في النفس والذهن خواطر عميقة، ومعاني كبيرة، وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم، وقواعد التربية والتهذيب، ومبادئ التشريع والتوجيه، ما يتجاوز حجمها وعدد آياتها مئات المرات!
وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة، هو أنها تكاد تستقل بوضع معالم كاملة، لعالم رفيع كريم نظيف سليم، متضمنة القواعد والأصول والمبادئ والمناهج، التي يقوم عليها هذا العالم، والتي تكفل قيامه أولاً، وصيانته أخيراً...عالم يصدر عن اللّه، ويتجه إلى اللّه، ويليق أن ينتسب إلى اللّه...عالم نقي القلب، نظيف المشاعر، عف اللسان، وقبل ذلك عف السريرة...عالم له أدب مع اللّه، وأدب مع رسوله، وأدب مع نفسه، وأدب مع غيره. أدب في هواجس ضميره، وفي حركات جوارحه. وفي الوقت ذاته له شرائعه المنظِّمة لأوضاعه، وله نظمه التي تكفل صيانته، وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب، وتنبثق منه، وتتسق معه، فيتوافى باطن هذا العالم وظاهره، وتتلاقى شرائعه ومشاعره، وتتوازن دوافعه وزواجره، وتتناسق أحاسيسه وخطاه، وهو يتجه ويتحرك إلى اللّه...ومن ثم لا يُوْكل قيام هذا العالم الرفيع الكريم النظيف السليم وصيانته، لمجرد أدب الضمير ونظافة الشعور، ولا يُوْكل كذلك لمجرد التشريع والتنظيم، بل يلتقي هذا بذاك في انسجام وتناسق. كذلك لا يُوْكل لشعور الفرد وجهده، كما لا يُترك لنظم الدولة وإجراءاتها. بل يلتقي فيه الأفراد بالدولة، والدولة بالأفراد، وتتلاقى واجباتهما ونشاطهما في تعاون واتساق.
هو عالم له أدب مع الله، ومع رسول الله، يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود العبد أمام الرب، والرسول الذي يبلغ عن الرب. انتهى كلام سيد.
وعلى الجملة، فإن السورة ابتدأت بالأدب الرفيع الذي أدب الله به المؤمنين، تجاه شريعة الله وأمر رسوله، وهو ألا يبرموا أمراً، أو يبدوا رأياً، أو يقضوا حكماً في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يستشيروه، ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة.
ثم انتقلت إلى أدب آخر، وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ تعظيماً لقدره الشريف، واحتراماً لمقامه السامي الرفيع، فإنه ليس كعامة الناس، بل هو رسول الله، ومن واجب المؤمنين أن يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقير والتعظيم والتبجيل.
ثم انتقلت السورة إلى تقرير دعائم المجتمع الفاضل، فأمرت المؤمنين بعدم السماع للإشاعات، وأمرت بالتثبت من الأنباء والأخبار، ولاسيما إن كان الخبر صادراً عن شخص غير عدل، أو شخص متهم، فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق، سببت كارثة من الكوارث، وكم من خبر لم يتثبت منه سامعه، جر وبالاً عظيماً، وأحدث انقساماً كبيراً.
وبينت السورة أن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون مجتمعاً نظيف المشاعر، مكفول الحرمات مصون الغيبة والحضرة، لا يؤخذ أحد بظنة، ولا يُعاقب لمجرد تهمة، ولا تتبع فيه العورات، ولا يتعرض أمن الناس وكرامتهم فيه لأدنى مساس، فحذرت من السخرية، ونفرت من الغيبة، ونهت عن التجسس، وإساءة الظن بالمؤمنين، ودعت إلى مكارم الأخلاق.
ودعت السورة إلى الإصلاح بين المتخاصمين، ودفع عدوان الباغين.
وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمز، ونفرت من الغيبة والتجسس، والظن السيء بالمؤمنين، ودعت إلى مكارم الأخلاق، والفضائل الاجتماعية، وحذرت من الغيبة بتعبير رائع عجيب، أبدعه القرآن غاية الإبداع، فجاء على صورة رجل يجلس إلى جنب أخ له ميت، ينهش منه، ويأكل لحمه!
بينت السورة أن الله تعالى خلق عباده من ذكر وأنثى، وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، لا ليتفاخروا بالأحساب والأنساب، فإن أكرمهم عند الله أتقاهم.
وختمت السورة بالحديث عن الأعراب، الذين ظنوا الايمان كلمة تقال باللسان، وجاءوا يمنون على الرسول إيمانهم، وقد وضحت حقيقة الإيمان، وحقيقة الإسلام، وشروط المؤمن الكامل، وهو الذي جمع الإيمان، والإخلاص والجهاد، والعمل الصالح.


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج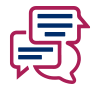 استشارات الحج
استشارات الحج

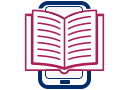












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات