
تشيع في ساحة الكتابة في عالمنا العربي أساليب «هُلاميَّةٌ» تائهةٌ في عوالم «التمايُه، والتَّشرذُم، والتساوُق، والتقاطُع، والتَّشَظِّي، والأَنْساق، والأَوْهاق، والطَّحالب، والتَّمَحْوُز، والتجذُّر..، إلى غير ذلك من التردِّي في أساليبَ عائمة هائمة، ليست بمستيقظةٍ ولا نائمة، ولا صاحية ولا حالمة، ولكنها قاتمة غائمة، أَساليب ضبابيَّة مسكونة بحبِّ التَّظاهر بالتجديد الكسيح، وادِّعاء القدرة على الرمز والتلميح، بينما هي غارقةٌ في «خَيْبة أقلام أَصحابها» الذين لا يصلون إلى قلوب المتذوقين، ولا يخاطبون مشاعر المتلقِّين، ولا يحسنون التعامُل مع أعظم لغةٍ يتعامل بها البشر، تعاملاً راقياً يناسب جمالَها وكمالَها، ويقدِّر قيمتها البيانية، وسموَّها البلاغي، ورونق كلماتها، ونصاعةَ أساليبها، وإشراق بديعها الذي يطرب ويعجب، ويرقى بذائقة القارئ لها، والمستمع إلى من يتحدَّث بها.
«أساليبُ هُلامية»، ومعنى هُلامية: مائعة مسترخية، ليس لها طعمٌ ولا لون ولا رائحة إلا رائحة التكلُّف والتفاصُح، والهِلَّم في لغتنا تعني المسترخي، يقال رجلٌ هِلَّمٌ وامرأةٌ هِلَّمَة، والهَلاَم مادةٌ رغويَّة، ونحن جميعاً نعرف ما للمادة الرّغوية من الرَّجْرَجة، وعدم الاستقرار، ونرى ما فيها من «الفُقَّاعات» التي لا تكاد تظهر حتى تختفي، ولا يمكن أن تثبت حتى تمسك بها يَدٌ أبداً.
الأسباب
وهذه الأساليب الهُلاميَّة عند بعض الكتاب العرب لها في نظري أسبابٌ ودواعٍ في نفوس أصحابها، منها:
حبُّ التَّظاهر بالمعاصَرة المعجونة بماء «التغريب» الذي لا يخلو من نجاسة ثقافية تحتاج إلى ماء «طهور» لإزالتها، ويظهر هذا حتى عند بعض الكتَّاب الذين يميلون إلى الرؤية الإسلامية في كتاباتهم، وقد رأيت ذلك عند طائفة من الكتبة في مغرب عالمنا الإسلامي ومشرقه، بل عند بعض أبناء جزيرة العرب التي ترفرف في أجوائها راية البيان العربي الذي تشرق شمسه منذ كان الشاعر العربي لسان قومه، وحامل لواء بلاغتهم قبل الإسلام إلى يومنا هذا، إلى ما يشاء الله، وهؤلاء المصابون بداء «الهُلاميَّة» يخلطون في كتاباتهم خَلْطاً قبيحاً بين وضوح الفكرة التي يريدون طرحها وضبابيَّة الأساليب التي يستخدمونها، «ورَغَويَّة» الجمل التي يركِّبونها، وينثرونها في كتاباتهم بطريقة تجعل الكلمات «تَزْلَقُ» فما تستطيع ثباتاً، ولا تقدر على وقوفٍ، ولا تقوى على السير خطوةً واحدةً إلى عقل القارئ وقلبه.
ومن أسباب تلك الأساليب «الهُلاميَّة» أيضا
الرَّغْبَة في التميُّز والتفرُّد تحت غطاء عدم «التقليديَّة» التي يتوهَّم المتوهِّمون أنها عيبٌ لا بد من التخلُّص منه، وأنَّها مَثْلَبَةٌ لا بد من معالجتها، والاحتراز منها، وهذا الغطاء الوَهمّي يجعل بعض الكتَّاب والنقَّاد يطلقون آراء غريبةً بعيدة عن الصحة والصَّواب، مع أن معنى «التقليديَّة» في أذهانهم مفهوم عائمٌ غائمٌ لا يستطيعون أن يرسموا له ملامح ظاهرة تراها العين.
إنه وباءٌ كتابي يحتاج إلى حملة «تطعيم» شاملة، حتى لا ينتشر فيقضي على جمال لغتنا الخالدة، وبياننا العربي الناصع.
إنَّ لغتنا العربية الفصحي أغنى لغة في العالم، فيها من الكنوز ما يحتاج إلى مهارةٍ ومقدرةٍ تتيح لنا استخراجها بعيداً عن «هُلاميَّة» الواهمين، وضبابيَّة المسكونين بوهم التجديد الرَّغَوي الذي يباعد بين أصحابه وبين كنوز لغة القرآن الكريم، إن لغتنا لغة ناصعة البيان، والنَّاصع الخالص الصَّافي من كلَّ شيء، ولذلك ورد في الأثر عن فضل المدينة المنورة: «فالمدينة كالكير تنفي خَبثَها، وتَنْصَعُ طِيْبَها»؛ أي تجعله خالصاً صافياً، وكذلك لغة القرآن تنفي خَبَث الكلمَات المنحرفة، وتَنْصَع طيب بيانها وبلاغتها.
يا خجلتي من حال أمتنا التي ... في وهمها تتلمَّس الحيطانا


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج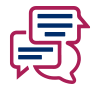 استشارات الحج
استشارات الحج

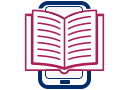












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات