
لو أن باحثا في الفقه الإسلامي بحث عن أقدم دستور بقي لنا بنص مواده في تراث الدساتير الإنسانية، فإن هذا الباحث لن يجد دستوراً سابقاً على دستور دولة النبوة، التي قامت بالمدينة المنورة (عام 1 هـ ، 622م).
قد يجد قوانين ترجع إلى عهد حمورابي (1792 - 1750 ق. م) لكنه لن يجد دستوراً كاملاً أقدم ولا أعرق من دستور دولة المدينة، التي رأسها نبي الإسلام، عليه الصلاة والسلام.
ولقد أطلقت المصادر التاريخية على هذا الدستور اسم "الصحيفة" و"الكتاب" وذلك انطلاقا من التسمية الواردة في نصه، فهو "كتاب من محمد النبي، رسول الله، بين المؤمنين والمسلمين، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، وبين غيرهم من أهل يثرب - (المدينة) - الذين دخلوا في رعية الدولة الجديدة دون أن يدخلوا في الإسلام الدين وفي جماعة المؤمنين، كما أطلق على هذا الدستور - في مواده - عبارة "أهل هذه الصحيفة" على الرعية المحكومين بهذا الدستور.
وإذا كان مصطلح "الدستور" من المصطلحات المعربة، التي دخلت العربية من اللغات الأخرى، وإذا كان هذا المصطلح يعني - حديثا - "مجموعة من القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ومدى سلطتها إزاء الأفراد"، فإن هذه "الصحيفة" و"الكتاب" هي دستور الدولة العربية الإسلامية الأولى، بكل ما يعنيه - حديثا - مصطلح الدستور من مضامين.
وإذا كانت مصادر التاريخ لا تذكر لنا كيف "وضع وصيغ" هذا الدستور، فإننا - بحكم القاعدة الإسلامية الشرعية - نميل إلى أن وضعه وصياغته هي ثمرة لمشاورة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لوجوه الرعية، الذين يسمون فيه "أهل هذه الصحيفة"، فهو نص ينظم شئون الدولة ويقنن العلاقة الدنيوية بين رعيتها بالدرجة الأولى، ومن ثم فإن موضوعه هو مما تجب فيه الشورى الإسلامية، وفق منطوق ومفهوم القرآن الكريم.
ولقد صيغ هذا الدستور لينظم القواعد الأساسية لدولة المدينة ورعيتها، بعد أن نزل الوحي بقسم كبير من القرآن الكريم، فكان ذلك دليلا على أن "القرآن" بالنسبة لدستور الدولة، هو الإطار، فيه "المبادئ" وبه "الروح" والمقاصد والضوابط والغايات، وليس هو نص الدستور وذات مواده وعين قوانينه، فوجود القرآن الكريم لا يغني - في نظام الدولة - عن الدستور الذي يضبط القواعد وينظم الحقوق ويحكم العلاقات ويصوغ جميع ذلك صياغة دستورية محكمة الدلالة بينة الحدود.
وإذا كانت الدولة التي صيغ هذا الدستور مع تأسيسها قد قامت عام 1 هـ، 622 م، فإن حقيقة وجود دستور مكتوب لهذه الدولة، هي سنة من سنن السياسة الشرعية الإسلامية، لا تدعو إلى الفخار فحسب، وإنما تدعو - قبل ذلك وفوقه - إلى العض عليها بالنواجذ، كي لا تغيب هذه السنة من قسمات "الدولة" ومقوماتها في دنيا الإسلام، وواقع السياسية الشرعية عند المسلمين، فغيابها - شكلا أو فعلا - عار لا يليق بخلف عرف أسلافهم هذه السنة الحسنة قبل أربعة عشر قرنا، فضلا عن أن غيابها إنما يفتح الباب لضياع الحقوق والمصالح التي جاءت لتحقيقها رسالة الإسلام.


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج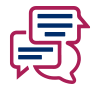 استشارات الحج
استشارات الحج

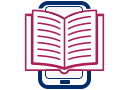












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات