
إنها أم هانئ فاختة بنت أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ابنة عم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وأخت على بن أبي طالب - رضى الله عنه-، كانت قبل إسلامها تدفع عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذى المشركين، وقد أسلمت ـ رضي الله عنها ـ يوم فتح مكة، الذي كان لها فيه موقف مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سجلته كتب السنة والسيرة النبوية .
في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة فتح الله ـ عز وجل ـ لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مكة المكرمة، وهو الفتح الأعظم، الذي أعز الله به دينه ورسوله، ودخل به الناس في دين الله أفواجا، قال الله تعالى: { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا }(الفتح الآية: 1 )، وفي أثناء هذا الفتح والنصر المبين، فرَّ بعض المشركين إلى بيت أم هانئ بنت أبي طالب ـ رضي الله عنها ـ، ولحقهم أخوها عليٌ ـ رضي الله عنه ـ ليقتلهم، وسألوها أن تجيرهم ففعلت، وذهبت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لتخبره بما حدث بينها وبين عليّ ـ رضي الله عنه ـ، وتروي ذلك فتقول :
( لما كان عام يوم الفتح فرّ إليّ رجلان من بني مخزوم فأجَرْتُهُما، قالت: فدخل علىَّ عليٌّ فقال: أقتلهما، قالت: فلما سمعته يقول ذلك أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ وهو بأعلى مكة، فلما رآني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ رحّب وقال: ما جاء بك يا أم هانئ، قالت: قلت يا رسول الله، كنت أمّنت رجلين من أحمائي، فأراد عليّ قتلهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: قد أجرنا من أجرت، ثم قام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى غسله فسترته فاطمة، ثم أخذ ثوبا فالتحف به، ثم صلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ثمان ركعات سبحة الضّحى ) رواه مسلم، وفي رواية البخاري قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها: ( مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئٍ .. قدْ أَجَرنَا مَنْ أَجَرتِ يَا أُمَّ هَانِئ )، وفي رواية أحمد: أنهما رجلان من أحمائها، فقال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:( قد أجرنا من أجرت، وأمَّنا من أمَّنت فلا يقتلنَّهما ) .
وقد بوب البخاري على هذا فقال: " باب أمان النساء وجوارهن " .
العرب في الجاهلية كانوا يدافعون عن الجِوار، ويَمنعون مَنْ حالَفهم أو استَجار بهم، ممَّا يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، بَيْد أنهم كانوا يُسرِفون في ذلك إسرافًا جائراً، يُجاوز حدود العدل والحق، فكانوا يشنُّون الحروب والغارات، انتصاراً لمن حالَف أو استجار، مُحقًّا كان أو مُبْطِلاً، ظالمًا كان أو عادلاً .. فلمَّا جاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهُدى والنُّور، هذَّب أخلاقَهم، ونفى منها الخَبَث والرِّجْس، وأقرَّ ـ فيما أقر من مكارم الأخلاق ـ حُسْنَ الجوار، في غير بغي ولا عُدوان، بل فرض على المسلم أن ينصرَ أخاه ظالماً أو مظلوماً، فلمَّا وقع على أصحابه الدهشة من دعوتهم إلى نصر أخيهم ولو كان ظالماً، بيَّن لهم أن ليس نصر الظالم ما ألِفُوهُ في الجاهلية الأولى من نصره في كل حال، وإنما هو كفُّه عن الظلمِ، والأخذُ على يدَيه إذا كان ظالماً، حتى ينتهي، فعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل: يا رسولَ الله، أنصرُه إذا كان مظلوماً، أفرأيتَ إذا كان ظالماً كيف أنصرُه؟، قال: تحجِزُه، أو تمنعُه، من الظلمِ فإنَّ ذلك نصرُه ) رواه البخاري .
وقد بلَغَ من عناية النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالجوار وحبِّه له، أن أجاز لكلِّ مسلم ـ رجلاً كان أو امرأة ـ أن يُجير ويؤمِّن، وجعَل أمانهم كشيء واحد، فلو صدر أمان من أحدهم لأحد من الناس فليس لأحد أن ينقضَهُ، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الأمان، منها :
ما رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( ذمةُ المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم، فَمَنْ أَخْفَرَ مسلمًا فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يقبل اللهُ منه صرفًا (فريضة) ولا عدلًا (نافلة) ) .
وروى أبو يعلى عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: ( ذمة المسلمين واحدة، فإن أجارت عليهم امرأة فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يوم القيامة ) .
قال النووي: " المراد بالذمة هنا الأمان، ومعناه: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمَّنه به أحد من المسلمين حَرُم على غيره التعرُّض له، ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله ) معناه: من نقض أمانَ مسلم فتعرَّض لكافر أمَّنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال: أخفرتُ الرجل إذا نقضتُ عهده، وخفرته إذا أمَّنته " .
وقال ابن حجر: " قوله: ( ذمة المسلمين واحدة ) أي أمانهم صحيح، فإذا أمَّنَ الكافرَ واحدٌ منهم حرم على غيره التعرض له " .
وقال الترمذي: " ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم " .
وقد أجارت زينب ـ رضي الله عنها ـ بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ: ( أن زينب بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أجارت العاص بن الربيع، فأجاز رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ جوارها ) رواه الطبراني .
قال الخطابي: " أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز " .
وقال ابن بطال: " إن كل من أمَّن أحداً من الحربيين جاز أمانه على جميع المسلمين دَنِيَّاً كان أو شريفا، حراً كان أو عبداً، رجلا أو امرأة، وليس لهم أن يخفروه " .
وجاء في عون المعبود: " ( يسعى بذمتهم ) أي: بأمانهم، ( أدناهم ) أيْ: عددا وهو الواحد، أو منزلة " .
وقال في شرح السنة: أي أن واحداً من المسلمين إذا أمَّن كافراً حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المجير أدناهم " .
لم يعتبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجوار مجرَّد نافلة فاضلة، وإنما عدَّه عَقدًا لازماً يجب احترامه، وعهدًا مسؤولاً ينبغي الوفاء به، مما لا يوجد له نظيرٌ في قانون دولي على وجه الأرض، هذا إلى ما يضيفه على المُجِير نفسه - وإن قلَّ شأنه - من معاني الإعزاز والتكريم، وأيُّ عزة يشعر بها المسلم، وهو يعلم أن له الحق في أن يُجير مَن استجار به، ويَحمي من التجأ إليه، ولا شك أنه حينئذٍ سيستعمل هذا الحقَّ في الخير والمصلحة العامة التي حددها الشرع، وكفى بهذا تقديرًا وتكريماً من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمسلم ـ رجلا كان أو امرأة ـ، وهذه المعاني واضحة ومستنبطة من موقفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع أم هانئ ـ رضي الله عنها ـ وقوله لها: : ( قَدْ أَجَرنَا مَنْ أَجَرتِ يَا أُمَّ هانئ ) .
وفي ذلك أيضاً إشارة واضحة من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تكريم المرأة، التي كانت قبل بعثته مهضومة الحقوق، مغلوبة على أمرها، ووصل بها الأمر إلى قتلها في مهدها وهي طفلة صغيرة، فأعاد لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مكانتها، ورفع الظلم عنها، وأوصى بحفظ حقوقها، وإعلاء شأنها، وجعلها شقيقة الرجل، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجال ) رواه أحمد، بل وجعل لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الحق في أن تُجير من تريد ـ في حدود الشرع ـ، ولا نظير لذلك في أي مجتمع آخر، مهما ادعى الحفاظ على حقوق المرأة وتكريمها .


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج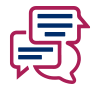 استشارات الحج
استشارات الحج

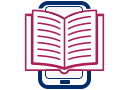












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات