
تروي كتب التاريخ أن قدماء الصين عندما أرادوا أن يدرءوا عن أنفسهم خطر الغارات الخارجية المتتالية على بلادهم؛ بنوا سور الصين العظيم .. تلك المعجزة المعمارية الحصينة، إلا أنه خلال المائة سنة اﻷولى من بناء السور تعرضت الصين لثلاث غزوات ناجحة، وفى كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية في حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه، بل يرشون الحارس ويدخلون عبر أبواب السور .. لقد انشغل الصينيون ببناء السور، ونسوا بناء الحارس!.
بل كم حدثنا التاريخ والواقع المعاصر عن أشكال من البناء المظهري للإنسان سواء على صعيد الرعاية الصحية أو الفكرية أو التعليمية المادية أو حتى التربية الشكلية التي أفرزت لنا المهندس والطبيب والمعلم .. وغيرهم ممن يتقنون مهنتهم ولا يعرفون شيئا عن أخلاقياتها، ودارت مناهج الإدارة وتربية الذات الإنسانية حول مواضيع الطموح والشخصية وطرق التفكير والتخطيط .. وغيرها من الموضوعات التي كرست نفسها لإنتاج الفرد الذكي والبارع والناجح .. والعديد من أوصاف الإنسان «السوبر مان» ذلك الرجل الجبار الذي يصارع الأقدار.
وإن اختلف معنا البعض حول دور «التربية الإيمانية الربانية» في بناء الإنسان، فدعونا نأخذ هؤلاء المخالفين في جولة في العديد من مجتمعاتنا العلمانية التي همشت دور الدين وقلصت المناهج الإسلامية من خريطتها التعليمية والتربوية، لنرى معهم إنسانا مسخا يجمع بين متناقضات لا يجمع بينها إنسان سوي ، ويعيش بمنطق عقله وحده الذي يبرر له أي موقف أو سلوك ينتهجه مهما كان قبحه وشينه، فلا يميز بين حلال وحرام أو بين الأخلاقي والإباحي، أو بين المقبول والمرفوض .. حتى اختفى وصف الصالح والتقي والورع، وتلاشت أخلاق التضحية والشهامة والمروءة والوفاء، وحلت محلها ثقافة الربحية والوصولية والنفعية ...
وكم قابلنا من أمثال هؤلاء الذين يصومون رمضان ولا يصلون، ورأينا الحجاب الكاجوال، والمايوه الإسلامي، والجراح الذي سرق كليه مريضه، وسماسرة الأعضاء البشرية، والتاجر الذي يصور خلسة زبائنه من السيدات أثناء قياس الملابس، والمحامي الذي يبيع موكله لخصمه لأنه دفع له أكثر، والذي يقدم لحم القطط والحمير لزبائن مطعمه .. والنماذج تفوق الحصر والوصف.
أزمتنا «دينية» أو «أخلاقية» .. كلا اللفظين مرادف لقضية واحدة. من العقيدة الصافية ينبغي أن يكون الانطلاق نحو بناء حقيقي للإنسان والمجتمع، فبالرغم من التقدم المادي الغربي ظل الخواء الروحي جاثما فوق صدورهم وأفرز مشاكل جسام من معدلات مخيفة للجريمة والإباحية والتفكك الأسري والأمراض النفسية والجنسية، وقد تفطنوا مؤخرا إلى هذا الفراغ الأخلاقي وتنادوا فيما بينهم بضرورة " أخلقة " كافة نواحي الحياة للحد من طوفان الانهيار السلوكي الذي يجتاح أفرادهم ومجتمعاتهم.
إن الظفر والنصر دوم لأصحاب العقائد الإيمانية الصافية، لأن العقيدة من شأنها أن تربط الفرد برسالة ممتدة في الدنيا والآخرة، رسالة يتبناها بحب، وهذا «الحب الإيماني» من شأنه أن يرسخ الفضائل، ويفجر الطاقات، ويذلل الصعاب، ويهون الخطوب، ويقيل العثرات، ويشيد الحضارات، ويقيم الأمجاد.
العقيدة الإسلامية ليست كعقيدة الفلاسفة - باعتبارها نظرية فكرية تقبع في زوايا الدماغ - بل هي قوة تتحرك في القلب وتنعكس ايجابيا على النَّفس والجوارح، فيندفع معتنقها إلى ميادين العمل والبناء، وعليه فقد كانت قوة فاعلة ومحرِّكة، غيّرت مجرى التاريخ، وبدّلت معالم الحضارة، وأحدثت في حياة الإنسان الاجتماعية والفكرية انقلابات رائعة، وحققت انتصارات عسكرية مشهودة.
وقد ذكروا أن صلاح الدين الأيوبي وعى هذا المبدأ جيدا .. فقد ذهب إلى صلاة الفجر في المسجد الأموي بعد أن أقيمت الصلاة ولم يكتمل الصف الأول، وبعد سبع سنوات ذهب إلى المسجد نفسه بعد أن أقيمت الصلاة فلم يجد له مكانا وصلى في الساحة الخارجية .. عندها توكل على الله تعالى وشن الحرب على الصليبين وكان النصر حليفه.
البيئة الحاضنة
«التربية الإيمانية» أحد شقي قضية بناء الإنسان، أما الشق الآخر فيتمثل في «البيئة الحاضنة» .. تلك البيئة التي يقوم على أمرها المجتمع والدولة التي ترسم من الخطط وتضع الأساليب والقوانين لضمان استنبات النشء استنباتا صالحا.
وأهم معلم من معالم البيئة الحاضنة «العدالة الاجتماعية» .. تلك العدالة التي يتساوى فيها أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، فلا امتيازات لطبقة أو حزب أو مسئول .. وإلا كيف نصدع رءوس أبنائنا بالحديث عن العدل وأهميته، والمساواة وضرورتها، ثم يخرج إلى الشارع فيجد الناس تتفاضل بالوساطة والرشوة والمحسوبية وسوء استخدام السلطة .. عندها ستضمحل تلك المفاهيم السامية من رأسه، ويحدث عنده فصام من نوع غريب مفاده أن ما يدرسه على الأوراق شيء والواقع شيء آخر، فيأخذ من العلم صورته، وتصبح الشهادة الجامعية مجرد واجهة أدبية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالقيم والمهنية التي من خلالها ينفع المواطن أمته.
ومن معالم البيئة الحاضنة «توظيف الطاقات» فلابد للعالم أن يجد مردودا لعلمه، والصانع عائدا من صنعته، والمبدع من إبداعه .. ولن يكون هذا إلا بخطة ممنهجة لاستيعاب الشباب الذي يتخرج سنويا من المعاهد والجامعات كلا في مجاله الذي أفنى ردحا من الدهر في تعلمه، لكن للأسف باتت قضية البطالة ورم سرطاني في جسد الأمة، وصرنا نشاهد جامعي يعمل سائق تاكسي أو خباز أو حمال حقائب أو مساح أحذية .. تحت ضغط عوز الحاجة وفقر العيش، فكيف لهؤلاء أن يثقوا بالمبادئ التي تعلموها وتربوا عليها بين دفتي الكتب وقد لفظهم المجتمع؟!.
ومن معالم البيئة الحاضنة «القدوة النموذجية» المتمثلة في الفضلاء من المشايخ والعلماء والمبدعين وغيرهم من أهل الوجاهة والتميز، الذين يجدون من المجتمع كل تقدير واحترام .. تلك الشخصيات النبيلة الفذة تمثل منارا هاديا لكل طالب حق، ودافعا قويا لكل صاحب طموح، أما أن تنقلب الأمور ويصير الرموز هم أهل الخلاعة والفحش فهذا بلاء ليس بعده بلاء، وقلب للمفاهيم، وتضليل، وتغرير بالشباب البريء الذي يكفر بكل قيمة تربى عليها عندما يرى (الثروة والشهرة) قد اجتمعت في أهل المجون، أما نجباء المجتمع فأغمار لا تسمع لهم ركزا.
إننا وإن كنا حريصون دوما على تربية أبنائنا على مبادئ: «الأعمال أعلى صوتا من الأقوال»، وأن آفة العلم ترك العمل به، وأن الشعارات الجوفاء لا تثمن ولا تغني من جوع .. إلا أن تلك البادئ الراقية من العار علينا أن تتلاشى بيننا في واقعنا العملي، الأمر الذي يحدث تخلخل لتلك المبادئ في النفوس عندما تخرج من المدرسة والجامعة (المحضن التربوي) فتجدها سرابا لا وجود له على أرض الواقع، وينهدم بنيان الإنسان الذي أنفقت عليه الدولة الكثير في ميزانيات وزارات التربية والتعليم التي أثقلت كاهل الأمة.
لا معنى مطلقا لبناء الإنسان في مجتمع نظري وعلى مبادئ أكثر ما يقال فيها أنها حبر على ورق، ولا معنى أن نطالب أبنائنا بالمثالية والمجتمع قد جحدها من قديم الزمن، ولا معنى أن نرتكز على قضية بناء الإنسان وحده دون خلق مردود واقعي يكمل البناء ويزيده متانة ورسوخا.


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج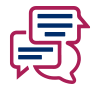 استشارات الحج
استشارات الحج

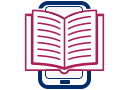












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات