
الحياة أعز شيء على الإنسان، وإن أعظم شيء من اختلال الأمم اختلال حفظ نفوسها. وقد أفرط عرب الجاهلية في إضاعة هذا الأصل، يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم، فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك، لولا أن تداركهم الله فيه بنعمة الإسلام. في هذا السياق يأتي قوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} (البقرة:178). لنا مع هذه الآية وقفات نستعرض فيها ما تضمنته من أحكام القصاص:
الوقفة الأولى: قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص}، فـ {كتب} معناه فُرِض وأُثبت. و{القصاص} مأخوذ من قص الأثر: وهو اتباعه، ومنه القاص؛ لأنه يتبع الآثار والأخبار. فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل، فقص أثره فيها، ومشى على سبيله في ذلك، ومنه قوله سبحانه: {فارتدا على آثارهما قصصا} (الكهف:64). وصورة القصاص: أن القاتل فُرِض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله، والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فُرِضَ عليه الوقوف عند قاتل وليه، وترك التعدي على غيره، كما كانت العرب تتعدى، فتقتل الرجلَ بالمرأة، والحرَّ بالعبد.
ولا خلاف أن القصاص لا يقيمه إلا أولو الأمر، فُرِضَ عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود وغير ذلك. وليس القصاص بلازم، إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو، فذلك مباح.
الوقفة الثانية: قوله سبحانه: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} مفهوم القيد يقتضي أن الحر يُقتل بالحر لا بغيره، والعبد يُقتل بالعبد لا بغيره، والأنثى تُقتل بالأنثى لا بغيرها. وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفهوم غير معمول به باطراد، قال ابن عاشور: "الظاهر أن القيد خرج مخرج الغالب، فإن الجاري في العرف أن الأنثى لا تَقتل إلا أنثى، إذ لا يتقاتل الرجال والنساء". لكنهم اختلفوا في المقدار المعمول به منه بحسب اختلاف الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، وحاصل أقوالهم وَفْق التالي:
فمذهب الجمهور أن الحر لا يُقتل بالعبد، والمسلم لا يُقتل بالذمي. ومناط الاستدلال عندهم، أن الله قد أوجب المساواة، ثم بين المساواة المعتبرة، فبين أن الحر يساويه الحر، والعبد يساويه العبد، والأنثى تساويها الأنثى، فكأنه كتب أن يُقتل القاتل إذا كان مساوياً للمقتول في الحرية، فعندهم أن قوله سبحانه: {القصاص في القتلى}، وقوله عز وجل: {النفس بالنفس} لفظ عام، خصصه قوله بعد: {الحر بالحر والعبد بالعبد}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يُقتل مسلم بكافر) أخرجه البخاري. وقد كان موجَب التقسيم ألا يُقتل الرجل بالمرأة، ولكن جاء الإجماع على أن الرجل يُقتل بالمرأة. وأيضاً كان ظاهر الآية يفيد ألا يُقتل العبد بالحر، ولكنهم نظروا إلى المعنى، فرأوا أن العبد يُقتل بالعبد، فأولى أن يُقتل بالحر، فالآية عندهم قد جاءت لتبين من هم أقل في المساواة، فلا يُقتل بهم من هو أعلى منهم، فلا ينافي ذلك أن يُقتل الأنقص بالأزيد. وأيضاً، فإن مذهب الجمهور أن القصاص واقع فيما بين الرجال والنساء في الأنفس وما دونها.
ومذهب الشافعي وأحمد إلى نفي القصاص من المسلم للذمي والمعاهد، وقال مالك: لا قصاص من المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد قَتْل عدوان، وأثبت القصاص منه إذا قتل غيلة.
ومذهب الحنفية وأهل الظاهر أن الحر يُقتل بالعبد، والمسلم يُقتل بالذمي، واستدلوا لقولهم بعموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}، وبقوله سبحانه: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (المائدة:45)، ومأخذ الحنفية فيما ذهبوا إليه، أن الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية، وهذا يعم كل قاتل: سواء أكان حراً قتل عبداً، أم غيره. وسواء أكان مسلماً قتل ذميًّا أم غيره. فالحنفية ومن وافقهم أخذوا بعموم قوله {القتلى} ولم يثبتوا له مخصصاً، ولم يستثنوا منه إلا القصاص بين المسلم والكافر الحربي، واستثناؤهم لا خلاف فيه، ووجهه أن الحربي غير معصوم الدم، قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام.
قال الشيخ السايس تعقيباً على مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: "والعقل يميل إلى تأييد قول أبي حنيفة في هذه المسألة؛ لأن هذا التنويع والتقسيم الذي جعله الشافعية والمالكية بمثابة بيان المساواة المعتبرة، قد أخرجوا منه طرداً وعكساً الأنثى بالرجل؛ فذهبوا إلى أن الرجل يقتل بالأنثى، والأنثى تقتل بالرجل، وذهبوا إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، ولكنهم أجازوا قتل العبد بالحر، فهذا كله يُضْعِفُ مسلكهم في الآية. أما مسلك أبي حنيفة فيها فليس فيه هذا الضعف، وحينئذ يكون العبد مساوياً للحر، ويكون المسلم مساوياً للذمي في الحرمة، محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام".
الوقفة الثالثة: أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. والجمهور على وقوع القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وإنما هو في النفس بالنفس. وهو محجوج بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى.
الوقفة الرابعة: مذهب الجمهور أن الأب إذا قتل ابنه عمداً لا يُقتل به، لكن يدفع ديته، ومذهب مالك أنه إذا قتله متعمداً، مثل أن يضجعه ويذبحه، أو يصبره، مما لا عذر له فيه، ولا شبهة في ادعاء الخطأ، أنه يُقتل به قولاً واحداً. فأما إن رماه بالسلاح أدباً، أو حنقاً، فقتله، ففيه في المذهب قولان: يُقتل به، ولا يُقتل به وتغلظ الدية.
الوقفة الخامسة: مذهب الجمهور أن الجماعة تُقتل بالواحد، وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء، وقال: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً). وأيضاً، لو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلوا، لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم. وهم قد نظروا إلى المعنى، وهو أن الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس، {ولكم في القصاص حياة} (البقرة:179)، ولو علم الناس أن الجماعة لا تُقتل بالواحد لتمالأ الأعداء على قتل عدوهم، وبلغوا مرادهم من قتله، ونجوا من القود بالاجتماع. والآية لا تدل على أن الجماعة لا تُقتل بالواحد؛ لأنها جاءت في منع حميّة الجاهلية، التي كانت تدعو القبيلة إلى أن تقتل بقتيلها من قَتَل، ومن لم يَقْتِل؛ افتخاراً، بل قد يؤخذ من الآية ما يدل لمسلك الجمهور؛ لأن المراد بـ {القصاص} قَتْل من قَتَل، كائنا من كان، واحداً، أو جماعة.
وقال أهل الظاهر: لا تُقتل الجماعة بالواحد، واستندوا إلى ظاهر الآية؛ لأنها شَرَطت المساواة والمماثلة، ولا مساواة بين الواحد والجماعة.
ومذهب الحنفية أنه إذا اشترك صبي وبالغ، ومجنون وعاقل، وعامدٌ ومخطئ في قَتْل رجل، أنه لا قصاص على واحد منهما؛ لأن الأصل عندهم أنه متى اشترك اثنان في قَتْل رجل، وأحدهما لا يجب عليه القود، فلا قود على الآخر. ووافق الشافعي الحنفية في اشتراك العامد والمخطئ، أنه لا قود على العامد منهما، وخالفهم في اشتراك العاقل والمجنون، والصبي والبالغ، فأوجب القصاص على العاقل والبالغ.
الوقفة السادسة: اختلف الفقهاء في موجَب القتل العمد؛ فمذهب الجمهور أن ولي المقتول بالخيار: إن شاء اقتص من القاتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يرض القاتل، وإن شاء عفا. ومذهب الحنفية والمشهور عن مالك أنه ليس لولي المقتول إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل.
الوقفة السابعة: قوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} اختلف العلماء في المراد من هذا الجزء من الآية؛ وأرجح أقوالهم: أن المراد منها أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول، وأسقط القصاص، فإنه يأخذ الدية، ويَتْبَع بالمعروف، ويؤدي إليه القاتل الدية بإحسان، فمعنى {عفي له من أخيه شيء} أنه أعطى (العفو) أي: الميسور على القاتل من عوض الصلح، ومن معاني (العفو) أنه الميسور من المال، الذي لا يجحف بباذله. فـ (من) في الآية مراد بها ولي المقتول، والمراد بـ {أخيه} القاتل، وُصِفَ بأنه (أخ) تذكيراً بأخوة الإسلام، وترقيقاً لنفس ولي المقتول؛ لأنه إذا اعتبر القاتل أخاً له، كان من المروءة ألا يرضى بالقَوَد منه؛ لأنه كمن رضي بقتل أخيه.
الوقفة الثامنة: قوله سبحانه: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}، ذلك أن أهل التوراة كان لهم القتل، ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو، ولم يكن لهم قَوَد، ولا دية، فجعل الله تعالى ذلك تخفيفاً لهذه الأمة، فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا.
الوقفة التاسعة: قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} اختلف العلماء فيمن قَتَل بعد أخذ الدية؛ فقال مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة. وقال بعضهم: عذابه أن يُقتل البتة، ولا يُمَكِّن الحاكم الولي من العفو. وقال الحسن: عذابه أن يَرُدَّ الدية فحسب، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. قال ابن عاشور: "وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز بتفويضه إلى الإمام لينظر هل صار هذا القاتل مزهق أنفس، وينبغي إن عُفي عنه أن تشدد عليه العقوبة أكثر؛ لأن ذِكْرِ الله هذا الحكم بعد ذِكْرِ الرحمة دليل على أن هذا الجاني غير جدير في هاته المرة بمزيد الرحمة، وهذا موضع نظر من الفقه دقيق".
الوقفة العاشرة: ذهب مالك والشافعي إلى أن قوله سبحانه: {كتب عليكم القصاص} يقتضي المماثلة في كيفية القتل، فيُقتص من القاتل على الصفة التي قَتَل بها؛ فمن قَتَل تغريقاً، قُتِلَ تغريقاً، وهكذا. وذهب الحنفية إلى أن المطلوب بـ {القصاص} إتلاف نفس بنفس، والآية لا تقضي أكثر من ذلك. فعلى أي وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا قَوَد إلا بالسيف) رواه ابن ماجه.
الوقفة الحادية عشرة: استدل بالآية على أن الكبيرة لا تُخْرِج العبد المؤمن من إيمانه؛ فإنه لا شك في كون قتل العمد والعدوان من الكبائر إجماعاً، ومع هذا خاطبه بعد القتل بالإيمان وسماه -حال ما وجب عليه من القصاص- مؤمناً، وكذا أثبت الأخوة بينه وبين وليَّ الدم، وإنما أراد بذلك الأخوة الإيمانية، وكذا ندب إلى العفو عنه، وذا لا يليق إلا عن العبد المؤمن.


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج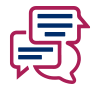 استشارات الحج
استشارات الحج

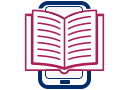












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات