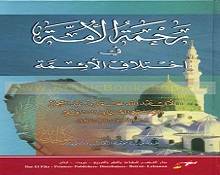
إن من الأساسيات الراسخة التي أرساها الأئمة إقرارهم بالاختلاف وأنه حتمية لا سبيل إلى تجاوزها أو إلغائها ، ولكن سبيلها البحث والعلم والتحري ، وهذا معيار لأهمية البناء العلمي الذي بموجبه جرى الخلف بينهم .
وإقرارهم بالإخاء والحب الذي هو برهان على أهمية البناء الأخلاقي الذي بموجبه جرى التصافي .
وقد نجد من بعدهم من اختلفوا فتحاربوا ، ونجد من توادعوا وتساكنوا لكن على غير علم ومعرفة .
ولذا صرفوا جل وقتهم في التعلم والتعليم ، وكان أبو حنيفة فقيه أهل العراق بغير منازع ، ومالك فقيه المدينة والحجاز ، ولم يُفت حتى شهد له أربعون من علماء المدينة ، وهو من أثبت الناس في الحديث ، والشافعي إمام في العديد من العلوم ، كاللغة والفقه والأصول ، ومن ثقات المحدثين ، وأحمد كان من الحفاظ الكبار .
كان أبو حنيفة أميل إلى الفقه ، وأحمد أميل إلى الحديث ، ومالك والشافعي وإن كانوا معدودين في مدرسة الحديث إلا أن لهم بصراً وأخذاً في الفقه قلّ نظيره .
وكان مالك يقول للعمري : (طلب العلم ليس أقل من العبادة لمن صلحت نيته).
وقال الشافعي : (طلب العلم أفضل من صلاة النافلة).
فحفظوا مقام العلم ، كما حفظوا مقام الأخلاق ، وأيّ علم بغير أخلاق فهو علم بلا عمل ، أو هو صورة العلم لا حقيقته ، فإن من أعظم العلم معرفة القطعيات ، ومن أعظم القطعيات معرفة القطعيات العملية ، ولذا فقد اتفقوا واتفقت الأمة كلها على وجوب محبة المؤمنين بعضهم بعضاً ، وعلى تحريم التباغض والتحاسد بين المؤمنين ، وعلى أن رباط الإخاء الإيماني لا يزول إلا بزوال أصل الإيمان من القلب ، وإن كان يتفاوت بتفاوته ، كما اتفقوا على حفظ الحقوق المنصوصة ، والالتزام بالأخلاق المفترضة بين الناس .
قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي ، ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ، ولقيني فأخذ بيدي ، ثم قال : يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة.
وقد يستوحش الشيوخ من الأقوال التي تطرق آذانهم لأول مرة ، ولم يسمعوها من أساتذتهم فينكرونها ، ثم يكون الغضب واللجاج وتراكم المشاعر السلبية المفضية إلى التفرق .
ويحسن في هذا السياق إيراد كلمة الإمام أحمد -رحمه الله- : " لم نزل نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فأصلح بيننا ".
لم يتحول الأمر إلى اصطفاف عقائدي مؤدلج ضد أهل الكوفة بحيث يكون معقد الولاء والبراء عليه ، ولا خلط الأئمة بين الأصول الثابتة المحكمة ، وبين الفروع المتغيرة الاجتهادية ، ومن هنا رحبوا بمدرسة الإمام الشافعي الجامعة ، والتي فيها قبس من مالك ، وآخر من أبي يوسف ، وشعبة من العراق ، وأخرى من الحجاز ، وتم لها النضج في مصر فجمعت ما تفرّق في البلاد .
وهكذا تكون المدارس التربوية أو الفقهية المتخالفة بحاجة إلى استعداد نفسي صادق لفهم المخالفين والتماس العذر لهم ، وترحيب بالمشروع العملي الميداني لتقريب وجهات النظر ، أو لتخفيف حدة النزاع .
وكان من جراء هذا التواضع العلمي ، والاستعداد النفسي ، مراجعة الأئمة لآرائهم ومواقفهم واجتهاداتهم وتعديلها إذا اقتضى الأمر .
كان للشافعي قول قديم بالعراق ، وأحدث قولاً جديداً بعد انتقاله إلى مصر ، كان ذلك بسبب زيادة علمه وفهمه ، وبسبب نضجه الحياتي ، ومعايشته بيئة جديدة مختلفة عما عرف من قبل ، وفيها عوائد وأعراف وأحوال لم يعهدها في العراق ، فضلاً عن السن الذي وصل إليه ومن الحجة للشافعي في ذلك ما تواتر من الفروق بين مجتمع المدينة ومجتمع مكة ، وقد ألف المناوي كتاباً سماه (فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد) ، وقد وجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة روايتان أو قولان للإمام نفسه في مسائل عديدة .
يقول أبو يوسف : " ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة ، إلا وهو قد قاله ثم رغب عنه " .
وقد خالف أبو حنيفة هنا نفسه ، ثم خالفه تلاميذه في معظم مسائل المذهب ، مع رجوعهم إلى الأصول والقواعد التي كان يقول بها .
وفي مذهب مالك نقل عنه إلى العراق نحو سبعين ألف مسألة ، فاختلف الناس في مذهبه لاختلاف نشرها في الآفاق .
أما في المذهب الحنبلي فثمّ ما يعرف بالوجهين والقولين ، والتي جمعت في طائفة كبيرة من كتب التلاميذ والرواة .
والمذهب الحنبلي غني بالروايات المتعددة ، التي تكون أحياناً بعدد الأقوال المأثورة في المسألة ، وفي المغني وغيره شيء كثير من ذلك .
وهذا يعود إلى طبيعة المسائل الفرعية وأن الأمر فيها قريب كما قال ابن تيمية.
إن الرجوع إلى رأي المخالف لا يكون إلا من إمام صادق ، مراده الله والدار الآخرة ، وهم كانوا كذلك .
لم يذعنوا لأتباعهم وتلاميذهم ، ولا فتحوا آذانهم لنقل الحديث عن زيد وعبيد ، على سبيل الذم والوقيعة وإيغار الصدور ، ولا حزبوا من وراءهم على طاعتهم واتباعهم ، وعيب مخالفيهم ، ولم يكونوا مذعنين لإرادة الطلاب ، ولا مأخوذين بكثرتهم ، بل كانوا مستقلين استقلالاً ذاتياً عن الأتباع مع حفظهم لحقوقهم ومقاماتهم .


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج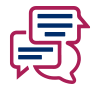 استشارات الحج
استشارات الحج

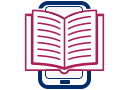












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات