
الكتابة المسلية تطرد بحروفها قطرات الأمل لتؤسس لعبودية فكرية عمادها نصوص تُرَص ولا تقول شيئا، تسد خلة الكاتب إلى الشهرة الكاذبة، وتسد عقل القارئ ونفسه لما حوته من ثقافة السخافة، وسخافة الثقافة".
فقرة قليلة الحروف ولكنها كبيرة المعنى اجتزأتها من النص الذي كتبه الدكتور مصطفى السيد في أحد أعداد مجلة البيان اللندنية حول دور الكتابة المسؤولة في ترشيد الواقع والارتقاء بالذات الإنسانية.
وفي هذه الفقرة ينتقد الكاتب ثقافة التسلية التي لا هدف لها سوى التهريج وملء المساحات البيضاء بنصوص تشعر القارئ البسيط بأنها ستروح عنه لكنها تغرقه بالتسطيح وتمعن في خداعه عبر الميزان المائل الذي تحتكم إليه.
التسلية الهابطة التي يقدمها قلم غير مسؤول تتقاطع مع التسلية التي يقدمها عرض متلفز هدفه الإثارة وتصدير قيم رديئة للجمهور المولع بالفرجة دون قيد أو شرط.
وبذات القدر من التوهج الذي يتركه كاتب مسؤول في وجدان قارئ نوعي يحترم عقله وحواسه نجد بالمقابل بصمة سلبية لدى المتلقي الآخر الذي بحث عن التسلية مكتوبة أو مرئية دون أن يضع لنفسه خطوطا حمراء يقف عندها، ويسمو عن القفز فوقها تحت مبررات يعلم جيدا أنها دون دليل أو سند.
المتلقي الذي لا يهدف سوى إلى قتل الوقت، والحصول على متعة آنية من مادة إعلامية منظورة هو ذاته من يقرأ أقذع الروايات وأشدها إمعانا في العبث بمشاعر القارئ وإيصال رسائل سلبية إليه تفقده التوازن، وتسلبه الكثير من مميزات الفعل والتأثير.
والسؤال الذي يقفز من بين السطور لماذا يفقد الإنسان شعوره بالمسؤولية تجاه اختياراته وينخفض لديه الشعور بأهمية الانتقاء لما يشاهد وما يقرأ؟
هل يظن هؤلاء أن الحرية الشخصية تعني فساد الذوق والسير حتى النهاية مع العروض الهزيلة التي تطفأ حماس المرء للعمل، وتحوله لمستقبل سلبي يتأثر ولا يؤثر، وينفعل ولا يتفاعل، ويفتقد لمعيار يحتكم إليه ويسترشد به؟
أفليس من الجهالة وسوء التدبير أن يتمادى الفرد في متابعة الموجة الإعلامية السائدة فيغرق دون أن يجد يدا واحدة تمتد لإنقاذه من الورطة التي وقع فيها باختياره وعن سابق قصد وإصرار؟
كيف يقبل الفرد الناضج أن يهب عقله لمروجي العبث بحثا عن متعة آنية يكون ضريبتها إدمان تلك العروض الفارغة وملاحقتها من محطة لأخرى دون كلل أو ملل؟
والسؤال الآخر: أفتستحق تلك البرامج التي ينبذها العقلاء أن يدفع لأجلها الضريبة التي يدفعها المتلقي من عمره ووقته ورصيده من المعرفة والذي ينكمش ويتراجع في ظل سياسة الانفتاح غير المدروس مع العروض الهزيلة السالبة للعمر، والتي تصيب بأمراض الكسل والتواكل وقلة الدافعية للتطور والنمو؟
وكيف ينمو من يهب لصوص الوقت عمره، وكيف يتطور من يمنحهم عقله وجوارحه دون قيد أو شرط؟!!
إن للنجاح في الحياة قواعد وأسس لا بد من مراعاتها والالتزام بها وبالتأكيد ليس من بين تلك القواعد فتح الأبواب لكل من هب ودب من الخارجين عن حدود اللياقة والأدب الذين يستبيحون عين المشاهد ويستخفون بعقله، ويصورون له النجاح بمقاييسهم الشخصية والتي لم يلتزم أفرادها بالحد الأدنى من قواعد الأخلاق، أو الأعراف التي تراعيها الشعوب.
في مثل هذه العروض الرديئة يتخذ النجاح شكلا آخر غير الشكل المألوف لدى الناس، فالناجح في السينما هو بطل ذو صفات خاصة من أهمها أنه يشرب الخمر ويولع بالنساء وقد يكذب ويحتال في سبيل تحقيق الهدف الذي يريد.
في مثل هذه الأعمال المتلفزة تجد أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة جار تنفيذه بكل دقة واهتمام.. والبطل في السينما الأميركية التي لها نصيب الأسد في قنواتنا الفضائية هو شخص فوق العادة كل شيء لأجله مباح، وكل ما يقوم به من أعمال يتذرع بها لإنجاز هدفه النهائي تسبغ عليها الشرعية والقبول بغض النظر عن جنسها وماهيتها.
هذا التشويه للبطولة الحقيقية أفرز شريحة من المتلقين الذين لا يجدون في أنفسهم أدنى حرج من تقمص دور البطل الذي حددت هوليوود ملامحه وأوصافه.
والسؤال الجديد لمثل هذا المتلقي المعولم الذي فقد هويته وأصبح مغرما بمقاييس السينما الأميركية للنجاح والتميز ما الذي يمكن أن يقدمه لمجتمعه بعد أن تحقق هدف تطبيعه مع القيم المستوردة من الخارج؟
أي معنى للانتماء والثقافة في ظل الانبهار بالنموذج الغربي المعمم عالميا، وا لذي تستقبله أطباقنا الفضائية بكل ترحاب وحفاوة وإكبار؟
إن ولع المتلقي بالبحث عن المتعة المجردة دون ضوابط أو حدود سواء في التلفاز، أو من خلال الكلمة المكتوبة، أو عبر أي وسيلة اتصالية أخرى أدى لظهور الإنسان المعولم الفاقد لملامحه الذاتية، المنفصل عن هويته وتراثه.
ـــــــــــــــــــــــــ
مريم النعيمي


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج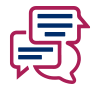 استشارات الحج
استشارات الحج

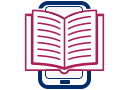












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات