
قدرة الأطفال المواظبين على مشاهدة التلفاز ممن هم دون سن السادسة على التركيز أثناء القراءة؛ كان موضوع بحث مؤسسة " كايزر فاميلي فاونديشن " الأميركية التي تتبعت أثر التلفاز على ميل الأطفال للقراءة، ومدى التقدم الذي يحرزه الأطفال المرتبطين ببرامج التلفاز مقارنة بأقرانهم ممن تقل ساعات بقائهم أمام هذا الجهاز عن ساعتين يوميا.
كانت النتيجة التي أحبطت " ألين وارتيلا " عميدة كلية الإعلام في جامعة تكساس، والمشاركة في إعداد هذه الدراسة هي: أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يبدؤون استخدام وسائل الإعلام في سن أصغر كثيرا مما كان يعتقد. وأنه في الوقت الذي بدأت فيه الأجيال السابقة علاقتها بالإعلام عبر الوسائل المطبوعة فإن الأجيال الجديدة تبدأ عبر الوسائل الإلكترونية.
النتيجة السلبية التي أفرزتها المتابعة المبكرة لبرامج التلفاز، أو اللعب بالبرامج الإلكترونية على شريحة الأطفال؛ تتجاوز البلد الذي أجريت فيه الدراسة إلى دول كثيرة تقع على رأس قائمتها الدول العربية التي يحقق فيها بعض الأطفال نسبا عالية تتجاوز الساعتين يوميا لتصل إلى أرقام مخيفة، وتنذر بالخطر الكبير.
من النتائج الأخرى التي توصل إليها البحث المذكور: أن الزمن الذي يخصصه جمهور الآباء والأمهات للقراءة للأطفال لا يتجاوز التسعة والثلاثين دقيقة الأمر الذي أفزع الباحثين بمؤسسة " كايزر فاميلي فاونديشن" وأثار انزعاجهم.
من الملاحظات الجديرة بالتأمل في هذا السياق: هو الالتفات إلى أهمية تعويد الطفل على رؤية الكتاب، والإصغاء لصوت الأب أو الأم وهما يقرآن له يوميا قصة جديدة تزخر بها مكتبته الخاصة التي تجهز عادة قبل ولادته.
ولا أدل على صدق هذه الثقافة المجتمعية الجديرة بالإعجاب؛ من أن تقف واحدة من أبرز مراكز الأبحاث الاجتماعية بالولايات المتحدة على هذه الحقيقة التي أكدت أصالة الانتماء إلى الفكرة الداعية للتسريع في دمج الطفل بعالم القراءة إن أريد له أن يكون شخصا ناجحا في المستقبل من أن يبلغ معدل الدقائق المخصصة يوميا للقراءة على الطفل تسعة وثلاثين دقيقة كجهد أسري ذاتي، لا يرتبط برياض الأطفال أو بنظام تعليمي معين.
ورغم هذه المعدلات الجيدة التي ننظر لها- نحن أبناء هذا العالم الغافل عن هذه المعاني- على أنها فتوحات أبوية غير عادية، تقف مؤسسة أميركية تتطلع للمستقبل بعيون صغارها موقفا مقللا لجهود الآباء في هذا المجال، حيث تراها جهودا متواضعة، ولا ترقى لتكون منافسا للأجهزة الإلكترونية التي اختطفت عالم الأطفال ورحلت بهم إلى دنيا كل ما فيها عنف وصخب وضجيج من شأنه أن يشعرهم بالإرهاق، ويبعدهم مسافات شاسعة عن عالم القراءة الهادئ والذي يحتاج نوعا من التفرغ الذهني الذي غدا مطلبا عسير المنال.
المقارنة بين أطفالنا وأطفال الأميركان في ظل هذه الدراسة لن تكون لصالحنا أبدا، فهي من جهة تدين سلوكياتنا غير المسؤولة التي تسقط عمدا وعن سبق إصرار وسيلة القراءة للطفل قبل بلوغه السن التي تؤهله لمزاولة القراءة بنفسه كخيار لا بد منه لدمجه في عالم المطالعة، ومن جهة ثانية تؤكد وجود مناخ مجتمعي صحي تخطى فيه أفراد المجتمع النظرة المغلقة للطرق الضيقة التي تبني الإنسان الناضج والتي- مع الأسف الشديد- نراها نحن في مجتمعاتنا عالما فسيحا لأبواب لا نهاية من النجاح، والتي لا تتجاوز في أذهاننا مخرجات النظام التعليمي الذي راهنّا عليه كجواد لا يخيب لأحلام عظيمة عجز عنها النظام السائد، وتخطاها النجاح الحقيقي الذي يأبى أن يتحقق بهذه الصورة المختزلة.
في حين قصرنا النجاح على شهادة دراسية جامعية أو ما بعدها تحرر العالم الصناعي من هذه النظرة، واعتمد خيار التعلم من المهد إلى اللحد منتهجا بذلك سياسة كنا في القرون الزاهرة نعرفها ونزاولها بشكل جماعي زمنا شهد لأسلافنا وأبى أن يشهد اليوم لنا.
إن من يجب أن يخاف على المستقبل "هو نحن بالدرجة الأولى"، فالتجربة الغنية التي تخوضها أسر الولايات المتحدة تكاد لا تتكرر في مجتمعاتنا إلا في أضيق نطاق ما يشير إلى حاجتنا الفعلية لمراجعة الذات، واستدراك مجالات القصور التربوي الذي نعاني منه.
ولو سألت- أيها القارئ الكريم- أغلب أصحابك عن نشاطهم الأبوي في هذا الجانب فقد تكون الإجابة مما يثير الأسى، ويؤكد وجود الخلل الذي نشير إليه.
الأمر مع الأمهات قد يكون أقل سوءا ولكنه على كل حال لن يعكس حالة من اليقظة الذهنية التي ما زلنا عنها بعيدين.
شيء من مراجعة الذات، وبعض الجهد في تحصيل قدر من الثقافة الأبوية المسؤولة؛ قد ينفع في تخفيف حدة الاحتقان الثقافي الذي يتكبد آثاره الصغار دون ذنب جنوه إلا وجودهم في محيط اجتماعي لا يقبل بسهولة أن يعتمد ثقافة تريح العقل من لغط الحياة المادية وتفتح له آفاقا من الأفكار العليا التي تصيغ الإنسان صياغة معرفية تنأى بصاحبها عن الإسفاف وصغائر الأعمال، وتضعه في الصدارة حيث يقف عن يمينه وشماله ثلة من النابهين، أما من حرموا من تلك التربية؛ فمآلهم إلى برامج الترفيه والتسلية، حيث وجدت لهم وهم بها فرحون.
ــــــــــــــــ
مريم عبد الله


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج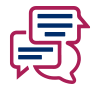 استشارات الحج
استشارات الحج

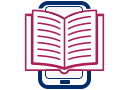












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات