
حديث القرآن عن الكفار والمشركين وموقفهم من الدعوة حديث مستفيض، وحديثه عن المنافقين والمتسترين برداء الدين حديث يحتل أيضاً حيزاً واسعاً في الكتاب الكريم. ولا عجب في ذلك؛ فإن الحياة لا تخلو على مر الدهور والعصور من هذين الصنفين من الناس.
ومن الآيات ذات الصلة بهذين الصنفين من الناس قوله سبحانه: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا} (البقرة:26). نقف في هذه السطور حول سبب نزول هذه الآية الكريمة.
ورد في سبب نزول هذه الآية ثلاث روايات متقاربة من جهة المضمون:
الرواية الأولى: ما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنه لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله: {مثلهم كمثل الذي استوقد نارا} (البقرة:17)، وقوله: {أو كصيب من السماء} (البقرة:19)، قال المنافقون: الله أعلى وأجلُّ من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها}. فهذه الرواية تدل على أن سبب نزول هذه الآية ما كان من قول المنافقين.
الرواية الثانية: روي عن قتادة قوله: لما ذكر الله العنكبوت والذباب، قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يُذكران؟! فأنزل الله هذه الآية. وفي راوية عنه ذكرها الطبري: قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها}. وهذه الرواية تدل على أن سبب نزول هذه الآية ما كان من قول المشركين.
الرواية الثالثة: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قوله سبحانه: {يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له} (الحج:73)، فطعن في أصنامهم، ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت، قالت اليهود: أي قدر للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله المثل بهما؟! فنزلت هذه الآية. وهذه الرواية تدل على أن سبب نزول هذه الآية ما كان من قول اليهود.
فالروايات الثلاث تفيد أن الآية نازلة إما في حق المنافقين، وإما في حق المشركين، وإما في حق اليهود.
وقد رجح الإمام الطبري أن تكون الآية نازلة في حق المنافقين لا في حق المشركين وأهل الضلال، فقال: أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحق، ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس؛ وذلك أن الله جل ذكره أخبر عباده أنه {لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها}، عقيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة، ضربها للمنافقين، دون الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها، فلأن يكون قوله: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما} جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما ضرب لهم من الأمثال في هذه السورة، أحق وأولى من أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور.
ولا يخفاك أن الطبري بنى ترجيحه لرواية ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما اعتماداً على سياق الآيات؛ إذ إن سياقها وارد في حق المنافقين، فكان الأنسب ترجيح هذه الرواية، لذلك وجدنا ابن كثير يعقب على اختيار الطبري بقوله: وهو مناسب.
ومما يرجح اختيار الطبري أن رواية ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أصح إسناداً من غيرها من الروايات على ما ذكره السيوطي في "أسباب النزول".
وقد سلك بعض المفسرين مسلك الجمع والتوفيق بين الروايات؛ فهذا الإمام الرازي يقول في هذا الصدد: احتمال الكل ههنا قائم؛ لأن الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود، وذكر المنافقين، وذكر المشركين. وكلهم من الذين كفروا.
وقريب من هذا مسلك ابن عاشور حيث قال: إن المشركين كانوا يفزعون إلى يهود يثرب في التشاور في شأن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيتلقون منهم صوراً من الكيد والتشغيب، فيكون قد تظاهر الفريقان على الطعن في بلاغة ضرب المثل بالعنكبوت والذباب، فلما أنزل الله تعالى تمثيل المنافقين بالذي استوقد ناراً، وكان معظمهم من اليهود هاجت نفوسهم، فاختلقوا هذه المطاعن، فقال كل فريق ما نُسب إليه، ونزلت الآية للرد على الفريقين.
غير أن ابن عاشور عاد ليقرر قيام الاحتمالات الأخرى، اعتماداً على أدلة سياقية، فذكر احتمال أن يكون قائل هذا القول اليهود؛ لكونه هو الموافق لكون السورة نزلت بالمدينة، وكان أشد المعاندين فيها هم اليهود؛ ولأنه الأوفق بقوله تعالى: {وما يضل به إلا الفاسقين * الذين ينقضون عهد الله} (البقرة:26-27)، وهذه صفة اليهود؛ ولأن اليهود قد شاع بينهم التشاؤم والغلو في الحذر من مدلولات الألفاظ، حتى اشتهروا باستعمال الكلام الموجه بالشتم والذم كقولهم {راعنا} (البقرة:104)، قال تعالى: {فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم} (البقرة:59)، ولم يكن ذلك من شأن العرب.
كما ذكر احتمال أن يكون قائله المشركون من أهل مكة مع علمهم بوقوع مثله في كلام بلغائهم، كقولهم: أَجرأ من ذبابة، وأطيش من فراشة، وأضعف من بعوضة. وهذا الاحتمال أدَلُّ، على أنهم ما قالوا هذا التمثيل إلا مكابرة ومعاندة، فإنهم لما غُلبوا بالتحدي، وعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله، تعلقوا في معاذيرهم بهاته السفاسف. والسورة وإن كانت مدنية، فإن المشركين لم يزالوا يُلقون الشبه في صحة الرسالة، ويشيعون ذلك بعد الهجرة بواسطة المنافقين. وقد دل على هذا المعنى قوله سبحانه بعده: {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا}.
ومهما يكن فالخطب يسير، ولا يترتب كبير فائدة على من يكون قائل ذلك. والمهم فيما وراء أسباب النزول، أن الآية تفيد أن الله سبحانه له أن يضرب من الأمثال ما يشاء، وبأي الأشياء شاء، ما دامت الغاية من ضرب الأمثال توضيح المراد، وتقريب البعيد، وجعل ما هو مجرد أقرب ما يكون إلى فهم الناس ومعتادهم.


 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج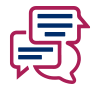 استشارات الحج
استشارات الحج

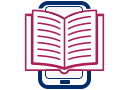












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات