الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الحقائق المقررة والأمور المشاهدة: التفاوت الظاهر بين الناس في مواهبهم ومقاديرهم وأرزاقهم، وغير ذلك من أحوالهم، وهذا ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه، حيث فاضل بينهم في الرزق، وفاوت بينهم في العطاء، كما قال سبحانه: وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ {النحل:71} ولولا هذا التفاوت الذي يُحْوِج الناس بعضهم إلى بعض، لما استقامت معايش الناس على الأرض، كما أشار إليه قوله عز وجل: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا {الزخرف:32}. وراجعي في ذلك الفتاوى: 74728، 388123، 102906، 105093.
وإن كنا نقول: الغنَى أفضل من الفقر، والطول أفضل من القصر، والبياض أفضل من السواد، والصحة أفضل من المرض، والقوة أفضل من الضعف، والاعتدال أفضل من النحافة ومن البدانة، وغير ذلك مما لا ينكره الناس من أنواع المفاضلة التي قسمها الله فيهم، إلا أن هذا لا يعني أن: الغني أفضل من الفقير، أو الطويل أفضل من القصير، أو الأبيض أفضل من الأسود ... وهكذا.
وكذلك نقول: إن كانت الذكورة أفضل من الأنوثة، والعروبة أفضل من العجمة، إلا أن هذا لا يعني أن الذكر خير من الأنثى، أو العربي خير من العجمي؛ وذلك أن تفضيل النوع والصنف، يختلف عن تفضيل العين والفرد، حتى في أحكام الدنيا، فضلا عن أحكام الآخرة.
ومن جملة الأمور التي فاوت الله تعالى بين عباده فيها: أنسابهم، فاصطفى بعضهم، ورفع بعضهم فوق بعض؛ تشريفا وتكليفا، حتى بين الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ [البقرة: 253].
ومن هذا أيضا: اصطفاء الله لخاتم أنبيائه من بني هاشم، واصطفاؤه لبني هاشم من قريش، ولقريش من كنانة، ولكنانة من ولد إسماعيل، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعله بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا يدل على فضل العرب من حيث الجنس والعموم، لا من حيث الأعيان والأفراد، وراجعي في ذلك الفتوى: 47559.
ثم إنه لا بد من اعتبار أن الفضل: منه ما هو مكتسب، ويحصل باختيار المرء، كالإيمان والتقوى والعمل الصالح، ومنه ما هو موهوب، ولا خيار للمرء فيه، كالنسب واللون والجنس. والمرء لا يذم على فقد الثاني، وإنما يذم على فقد الأول، والذي ينفعه عند الله إنما هو الأول لا الثاني.
فمثلا: إن كان جنس الذكورة أو البياض أفضل من جنس الأنوثة أو السواد، فهذا لا يعني أن كون الإنسان ذكرا أو أنثى، أبيض أو أسود، محلا للثناء والمدح أو الذم والقدح، من حيث الشخص ذاته، وإنما يحمد المرء ويذم على ما كسبته يداه.
والإسلام لا يفاضل بين الناس على أساس: اللون، أو الجنس، أو النسب، أو غير ذلك من الأمور الوهبية، وإنما يفاضل بينهم بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والفعل النافع، ونحو ذلك من الأمور الكسبية؛ ولذلك خطبَ رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللَّهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وخطب -صلى الله عليه وسلم- أيضا فِي حجة الوداع في أوسط أيام التشريق فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى. رواه أحمد وأبو نعيم والبيهقي، وصححه الألباني.
فالتفاخر بالأنساب من أمور الجاهلية التي ذمها الإسلام، وراجعي في ذلك الفتاوى: 53423، 123613، 26262.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: الأمور الخارجة عن نفس الإيمان والتقوى، لا يحصل بها فضيلة عند الله تعالى، وإنما يحصل بها الفضيلة عند الله إذا كانت مُعِينة على ذلك؛ فإنها من باب الوسائل لا المقاصد، كالمال والسلطان، والقوة والصحة ونحو ذلك، فإن هذه الأمور لا يفضل بها الرجل عند الله إلا إذا أعانته على طاعة الله بحسب ما يعينه. قال الله تعالى: {ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: " أتقاهم لله ". قيل: ليس عن هذا نسألك . قال: " يوسف نبي الله بن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم خليل الله " قيل: ليس عن هذا نسألك. قال: " أفعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".
بيَّن لهم أولا: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وإن لم يكن ابن نبي ولا أبا نبي، فإبراهيم النبي - صلى الله عليه وسلم - أكرم على الله من يوسف، وإن كان أبوه آزر، وهذا أبوه يعقوب. وكذلك نوح أكرم على الله من إسرائيل (يعقوب) وإن كان هذا أولاده أنبياء، وهذا أولاده ليسوا بأنبياء. فلما ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب، قال لهم: فأكرم أهل الأنساب من انتسب إلى الأنبياء، وليس في ولد آدم مثل يوسف؛ فإنه نبي ابن نبي ابن نبي. فلما أشاروا إلى أنه ليس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم، قال: "أفعن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" بين أن الأنساب كالمعادن، فإن الرجل يتولد منه كما يتولد من المعدن: الذهب والفضة. ولا ريب أن الأرض التي تنبت الذهب أفضل من الأرض التي تنبت الفضة. فهكذا من عرف أنه يلد الأفاضل، كان أولاده أفضل ممن عرف أنه يلد المفضول. لكن هذا سبب ومظنة وليس هو لازما، فربما تعطلت أرض الذهب، وربما قل نبتها، فحينئذ تكون أرض الفضة أحب إلى الإنسان من أرض معطلة. والفضة الكثيرة أحب إليهم من ذهب قليل لا يماثلها في القدر.
فلهذا كان أهل الأنساب الفاضلة يظن بهم الخير، ويكرمون لأجل ذلك. فإذا تحقق من أحدهم خلاف ذلك، كانت الحقيقة مقدمة على المظنة. وأما ما عند الله فلا يثبت على المظان ولا على الدلائل، إنما يثبت على ما يعلمه هو من الأعمال الصالحة، فلا يحتاج إلى دليل، ولا يجتزئ بالمظنة. فلهذا كان أكرم الخلق عنده أتقاهم.
فإذا قُدِّر تماثل اثنين عنده في التقوى، تماثلا في الدرجة، وإن كان أبو أحدهما أو ابنه أفضل من أبي الآخر أو ابنه، لكن إن حصل له بسبب نسبه زيادة في التقوى كان أفضل لزيادة تقواه– إلى أن قال : -
وإذا تبين هذا فيقال: إذا كان الرجل أعجميا، والآخر من العرب، فنحن وإن كنا نقول مجملا: إن العرب أفضل جملة، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو داود وغيره: «لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب». وقال: «إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي، وفاجر شقي».
ولذلك إذا كان الرجل من أفناء العرب والعجم، وآخر من قريش، فهما عند الله بحسب تقواهما: إن تماثلا فيها تماثلا في الدرجة عند الله، وإن تفاضلا فيها تفاضلا في الدرجة. وكذلك إذا كان رجل من بني هاشم، ورجل من الناس أو العرب أو العجم، فأفضلهما عند الله أتقاهما، فإن تماثلا في التقوى تماثلا في الدرجة، ولا يفضل أحدهما عند الله لا بأبيه ولا ابنه، ولا بزوجته، ولا بعمه، ولا بأخيه كما أن الرجلين إن كانا عالمين بالطب أو الحساب، أو الفقه أو النحو، أو غير ذلك، فأكملهما بالعلم بذلك أعلمهما به، فإن تساويا في ذلك تساويا في العلم، ولا يكون أحدهما أعلم بكون أبيه أو ابنه أعلم من الآخر. وهكذا في الشجاعة والكرم، والزهد والدين.
إذا تبين ذلك، فالفضائل الخارجية لا عبرة بها عند الله تعالى، إلا أن تكون سببا في زيادة الفضائل الداخلية. وحينئذ فتكون الفضيلة بالفضائل الداخلية، وأما الفضائل البدنية فلا اعتبار بها إن لم تكن صادرة عن الفضيلة النفسانية. اهـ.
وهذا التقرير يبطل - بلا ريب - وصف الإسلام بالإثنية (العرقية).
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 
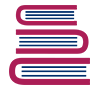
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات