الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يعين السائل وجه الاستدلال على ماذا؟ هل يقصد إثبات صفة الغيرة لله تعالى؟ أم يقصد الإخبار عنه سبحانه بالشخص؟
والأقرب إلى سياق السؤال، أنه يعني الثاني.
وإن كان كذلك، فالأمر محتمل، لا قطعي، قال عبد القادر الجيلاني الحنبلي في كتاب الغنية لطالبي طريق الحق: اختلف في جواز إطلاق تسميته بالشخص، فمن جوز ذلك؛ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: "لا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله". ومن منع ذلك، فلأن لفظ الخير ليس بصريح في الشخص؛ لاحتماله أن يكون معناه: لا أحد أغير من الله. وقد ورد في بعض الألفاظ: "لا أحد أغير من الله". اهـ. وذكر القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في كتابيه: (إبطال التأويلات، والمعتمد في أصول الدين) هذين الوجهين من الاحتمال:
فالأول: أن قوله: "لا شخص" نفي من إثبات؛ وذلك يقتضي الجنس، كقولك: لا رجل أكرم من زيد. يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل، كذلك قوله: "لا شخص أغير من الله"، يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الاسم. وأيَّده بحديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر، أنه خرج وافدًا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فذكر الرب تبارك وتعالى، فقال: "تنظرون إليه، وينظر إليكم" قال: قلت: يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض، وهو شخص واحد، فينظر إلينا، وننظر إليه؟ ... الحديث.
والثاني: منع إطلاق ذلك على الله، قال: لأن لفظ الخبر ليس بصريح فيه؛ لأن معناه: لا أحد أغير من الله؛ لأنه قد روي ذلك في لفظ آخر، فاستعمل لفظ الشخص في موضع: أحد، ويكون هذا استثناء من غير جنسه، ونوعه، كقوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ}، وليس الظن من نوع العلم، وقوله: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ}. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: أما هذا اللفظ، فقد جاء في الصحيح في بعض طرق حديث المغيرة بن شعبة، وترجم البخاري عليه في كتاب التوحيد ... وقد جاء لفظ الشخص في حديث آخر أصح من هذا، وهو حديث أبي رزين العقيلي ... وقد تنازع أهل الحديث من أصحاب أحمد، وغيرهم في إطلاق اسم الشخص عليه. اهـ. ثم نقل كلام أبي يعلى السابق، وأطال في رد كلام الرازي الموجب لتأويل لفظ الشخص بأنه الذات المعينة، والحقيقة، والمخصوصة، فراجع كلامه بطوله هناك.
وذكر ابن القيم في زاد المعاد حديثي المغيرة، وأبي رزين، وقال: والمخاطبون بهذا قوم عرب، يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولًا، وأصح أذهانًا، وأسلم قلوبًا من ذلك. اهـ.
وأما ما يتعلق بأفعل التفضيل، ودلالة هذه الصياغة على أن ما بعدها من جنس ما قبلها، فليس ذلك بلازم؛ ولذلك بقي الأمر محتملًا للمعنيين، قال الدماميني في شرح صحيح البخاري: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي إطلاقَ الشخص على الله تعالى، وما هو إلا بمثابة قولك: لا رجلَ أشجعُ من الأسد، وهذا لا يدلُّ على إطلاقِ الرجلِ على الأسد، بوجهٍ من الوجوه. اهـ.
وقال ابن جماعة في إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: معنى الكلام: ليس أحد من المخلوقين أغير من الله تعالى، ولا يلزم منه أن يكون مخلوًقا، وهو كقولهم: ليس أحد من بني تميم أعدل من عمر. وهو كلام صحيح، مع أن عمر قرشي وليس تميميًّا. ومنه ما روي في حديث: "ما خلق الله من جنة، ولا نار، أعظم من آية الكرسي". قال أحمد بن حنبل: الخلق هنا يرجع إلى المخلوق، لا إلى القرآن، فلم يلزم من ذلك أن تكون آية الكرسي مخلوقة. اهـ. ونقله عنه القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.
والمقصود هو إثبات الاحتمال، وأن الدلالة ليست قطعية.
ويبقى مسألة الترجيح، والاختيار، قال الشيخ عبد الرحمن البراك في تعليقاته على المخالفات العقدية في فتح الباري: المنكرون لإطلاق لفظ الشخص على الله تعالى - كابن بطال، والخطابي، وابن فورك-، لم يذكروا لهذا الإنكار دليلًا، إلا أن إثبات ذلك عندهم يستلزم أن يكون الله تعالى جسمًا. وهذه عين الشبهة التي نفت بها المعتزلة جميع الصفات، ونفى بها الأشاعرة ما نفوا من الصفات.
ومعلوم أن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب، والسنة نفيه، ولا إثباته، وهو لفظ مجمل، يحتمل حقًا وباطلًا، فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى في النفي، ولا في الإثبات، فعلم أن المنع من إطلاق الشخص على الله تعالى، مبني على هذه الشبهة الباطلة، التي نفيت بها كثير من الصفات، وهي باطلة، وما بني عليها باطل.
ودعوى الإجماع على منع إطلاق الشخص على الله تعالى، ودعوى التصحيف، كل ذلك ممنوع؛ فلا إجماع، ولا تصحيف، ولفظ الشخص يدل على الظهور، والارتفاع، والقيام بالنفس، فلو لم يرد في الحديث؛ لما صحّ نفيه؛ لعدم الموجب لذلك، بل لو قيل: يصح الإخبار به لصحةِ معناه؛ لكان له وجه، فكيف وقد ورد في الحديث، ونقله الأئمة، ولم يَرَوه مشكلًا!؟
فنقول: إن الله شخص، لا كالأشخاص، كما نقول مثل ذلك فيما ورد من الأسماء والصفات. اهـ.
وقال الشيخ في جواب له عن سؤال حول حديث المغيرة: وأما من ذهب من شراح الحديث إلى منع إطلاق الشخص على الله، محتجين بأن لفظ الحديث لا يدل على المطلوب من جهة اللغة، فما زعموه من عدم الدلالة، إنما يتعلق بأفعل التفضيل المضاف، كما ذكروا، ولفظ الحديث متضمن لنفي الجنس بـ (لا)، وأفعل التفضيل فيه غير مضاف، بل المفضَّل عليه مجرور بمن، لا مضاف إليه، ونظير لفظ الحديث أن تقول: لا رجلَ أكرمُ من زيد، ومعلوم أن هذا يدل على أن زيدا رجلٌ قطعًا. أمَّا لو كان لفظ الحديث: (الله أغيرُ شخص)، فإنه يمكن ـ احتمالًا ـ ألا يدل اللفظ على إطلاق الشخص على الله. انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.
وقد عقد الباحث يوسف الحوشان في رسالته للماجستير: (مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري) مطلبًا في إطلاق (الشخص) على الله، ومما قال فيه: لا يلزم في اللغة أن يكون المفضل عليه من جنس المفضل، فلا يلزم إذن أن يكون الله موصوفًا بالشخصية. ثم إذا سلم بالوصف بالشخصية -على قول من قال به-، فهو لا يلزم من كونه شخصًا أن يكون مماثلًا للأشخاص، فإن الله ليس كمثله شيء؛ حتى في اللفظة التي يستوي الإنسان والرب عز وجل، فإنه لا يماثله في حقيقة معناها، كما مرّ معنا في أكثر من إطلاق، قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}. اهـ. ثم قال بعد ذلك: والذي بان لي: أنه يجوز إطلاق لفظ الشخص؛ من باب الإخبار عن الله، ولكن ليس من باب التسمية؛ لأن شرط الأسماء أن تكون حسنى، بالغة الحسن أكمله، ولأنه لا يدعي بقوله: يا شخص، ولم يرد هذا اللفظ في جميع روايات من جمع الأسماء الحسنى. اهـ.
وهذا هو الذي يظهر لنا ترجيحه، وانظر للفائدة الفتوى: 98070.
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 


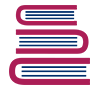
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات