الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تخلو من تعقيد وعدم وضوح.
والذي فهمناه من السؤال أن رأس مال المضاربة لم يحدد، فهو غير معلوم، وإن كان كذلك، فهذا يفسد المضاربة؛ لأن الجهالة بقدر رأس مالها يفسدها؛ إذ الجهل برأس المال يؤدي إلى الجهل بالربح، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون معلومًا للعاقدين، قدرًا وصفة وجنسًا، علمًا ترتفع به الجهالة ويدرأ النزاع، فإن لم يكن رأس المال معلومًا لهما كذلك فسدت المضاربة. وقالوا في تعليل ذلك: إن كون رأس مال المضاربة غير معلوم للعاقدين على النحو المذكور يؤدي إلى الجهل بالربح، وكون الربح معلومًا شرط صحة المضاربة. اهـ.
ومن أسباب فساد المضاربة أيضًا: أن يشترط المضارب راتبًا مقطوعًا، مع نسبته في الربح، فهذا لا يصح اشتراطه في المضاربة، وليس للمضارب إلا نصيبه المتفق عليه من الربح، قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ... وأجمع المسلمون جميعًا على أن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة، وكذلك إذا قال: الثلث إلا عشرة دراهم. بطلت المضاربة. اهـ.
ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر الإجماع الأول، ثم قال: وإنما لم يصح ذلك لمعنيين:
أحدهما: أنه إذا شرط دراهم معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءًا. وقد يربح كثيرًا، فيستضر من شرطت له الدراهم.
والثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء، لما تعذر كونها معلومة بالقدر، فإذا جهلت الأجزاء، فسدت، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلومًا به. ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم فائدته فيه، وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح. اهـ.
وأما مسألة التفرغ، فإن كان عمل المضارب في هذا المشروع لا يتم إلا به، فاشتراطها تحصيل للحاصل؛ لأن العمل في المضاربة واجب على العامل لا رب المال.
وأما إن كان قيام المشروع لا يستلزم تفرغ العامل، بل يمكنه إدارته، والقيام بما يلزمه دون أن يتفرغ، فلا حرج عليه أن يعمل في مال نفسه، أو أن يؤجر نفسه في عمل أو وظيفة أخرى لا تضر بواجبه في المضاربة؛ ولذلك منع بعض الفقهاء المضارب أن يضارب في مال لآخر إذا كان ذلك يضر بالأول، كما قال الخرقي في مختصره: إذا ضارب لرجل، لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل وربح، رده في شركة الأول. اهـ.
وقال ابن قدامة في شرحه: إن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن، مثل أن يكون المال الثاني كثيرًا يحتاج إلى أن يقطع زمانه، ويشغله عن التجارة في الأول، ويكون المال الأول كثيرًا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته، لم يجز له ذلك. اهـ.
والمقصود أن العمل في المال قد يقطع الزمان كله ويشغل عن غيره، ومن ثم يحتاج إلى التفرغ. ومع ذلك فليس للعامل إلا نسبته المتفق عليها في الربح. ومعلوم أن هذه النسبة تتفاوت من تجارة إلى أخرى، ومما يؤثر في تحديدها: مقدار الوقت والجهد الذي يبذله العامل.
وعلى أية حال؛ فالمضاربة إذا فسدت رجع رأس المال لصاحبه، وربح المال أو خسارته عليه، وأما المضارب فله أجرة مثله، قال ابن قدامة في المغني في المضاربة الفاسدة: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئًا، ولكن له أجر مثله ... اهـ.
وعلى ذلك؛ فالمقتنيات والتجهيزات التي تمت، ترجع لصاحب رأس المال، وأما ما قام به المضارب (السائل) من عمل، فيقدر بقيمته، وله عليه أجرة مثله، كأنه كان أجيرًا عند رب المال، قال علاء الدين السَّمَرْقندي في تحفة الفقهاء: إذا فسدت المضاربة بوجه من الوجوه، صارت إجارة. اهـ.
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

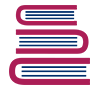
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات