السؤال
هل العيش في الحرم المكي والصلاة فيه كل الصلوات، أو أغلبها ـ مع العلم أنني إن لم أصلها في الحرم فسأصيلها في مسجد قريب ـ فيه خير وثواب أكثر من الصلاة إمامًا في مسجد خارج الحرم في مدينة غير مكة، مثل جدة، أو غيرها؟ وما هو الأعظم أجرًا؟ وهل الدعوة إلى الله أفضل من ذلك كله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلم نجد من أهل العلم من نص على المفاضلة بين جنس هذه الأعمال الثلاثة: الدعوة إلى الله تعالى، وإمامة الناس في غير مكة، وصلاة الجماعة فيها.
والذي نود التنبيه عليه هو أن قصد المكلف لاختيار أفضل الأعمال إنما يتجه عند التعارض بينها، وأما عند عدم التعارض، فالأفضل بلا ريب هو الجمع بينها؛ ولذلك نقول: إن شأن الدعوة إلى الله عظيم، ولا يخفى أنها لا تتعارض مع إقامة الصلاة، والإمامة فيها، سواء في مكة أم في غيرها، فلا ينفك مكان عن الحاجة إليها، وقد تكون مكة بما لها من شرف ومكانة، أحوج إلى القيام بواجب الدعوة فيها من غيرها من الأماكن؛ لأن الأجر والإثم كليهما يضاعف في مكة، فيحتاج المقيمون فيها إلى التعليم، والوعظ، والنصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كي يَقدروا هذا المكان قدره، ويقوموا بحقه، ويعظموا شعائره وحرماته، ناهيك عمن يأتي مكة من الحجاج والعمار ممن يحتاجون إلى الدعوة، وبيان معالم هذا الدين وأصوله، والترغيب في التمسك به، والذود عنه.
ويبقى أمر المفاضلة بين إمامة الناس في غير مكة، وبين الإقامة وصلاة الجماعة فيها، فلكل منهما ما يميزه، فالإمامة لمن تأهل لها، وقام بأمانتها لها فضيلتها وثوابها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49364.
وكذلك صلاة الجماعة في المسجد الحرام لا يخفى ما فيها من الفضل، ومضاعفة الأجر، ولكن في المقابل لكل واحد منهما تبعة ومسؤولية، فالإمامة مثلًا كرهها بعض أهل العلم، حتى قال الإمام الشافعي في الأم: وأكره الإمامة؛ للضمان، وما على الإمام فيها، وإذا أم رجل انبغى له أن يتقي الله عز ذكره، ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإذا فعل رجوت أن يكون خيرًا حالا من غيره. اهـ.
وكره بعض أهل العلم المجاورة في مكة لأجل أن السيئات فيها تضاعف هي الأخرى، كالحسنات، ولغيرها من العلل، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 272887، ورقم: 274246.
ولذلك؛ فإننا نرى أن المفاضلة بين هذين العملين الفاضلين يختلف حكمه بحسب الأشخاص والأحوال، ثم بحسب التأهل للإمامة، وحاجة الناس إليها، فقد سئل النبي صلى الله عله وسلم عدة مرات عن أفضل الأعمال، أو خيرها، أو أحبها إلى الله، فتعددت إجابته، فقيل في ذلك: إنه صلى الله عليه وسلم راعى حال السائل وحاجته، كما راعى اختلاف أحوال الناس وحاجاتهم، باختلاف الزمان، والمكان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 158421.
وننبه على أن الفاضل في حق شخص قد يكون مفضولًا في حق آخر، بل إن ذلك قد يقع للشخص الواحد بحسب اختلاف الحال، والزمان، والمكان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد يفتح على الإنسان في العمل المفضول ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل، وقد ييسر عليه هذا دون هذا، فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل، كالجائع إذا وجد الخبز المفضول متيسرًا عليه، والفاضل متعسرًا عليه، فإنه ينتفع بهذا الخبز المفضول، وشبعه واغتذاؤه به حينئذ أولى به. اهـ.
وقال أيضًا: قد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل؛ لكونه أنفع له، وكونه أرغب فيه، وهو أحب إليه من عمل أفضل منه؛ لكونه يعجز عنه، أو لم يتيسر له، فهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، وهو غير ما ثبت فضل جنسه بالشرع. اهـ.
وقال في موضع آخر: قد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين؛ لكونه عاجزًا عن الأفضل، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر، فيكون أفضل في حقه؛ لما يقترن به من مزيد عمله، وحبه، وإرادته، وانتفاعه، كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه، وإن كان جنس ذلك أفضل. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 119753.
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

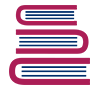
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات