الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يسع المفتي المجتهد أن يفتي بما يعتقد أنه خلاف الصواب، وأما حكاية مذهب غيره مما يسوغ فيه الخلاف، فلا حرج فيه.
جاء في (المسودة في أصول الفقه): إذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره؛ لأنه إنما سئل عما عنده، فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه. اهـ.
وفي هذا إلماح للجواب عن قول السائل: هل يختلف إن نسب القول لقائله أو تكلم به ابتداءً؟ فإن ذكر أي قول معتبر من أقوال العلماء على سبيل الحكاية ونسبة القول لقائله، لا حرج فيه.
وقال الطوفي في (شرح مختصر الروضة): يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم، اتفاقًا فيهما" أي: في الصورتين المذكورتين. أي: أن العامي يجوز له تقليد المجتهد بالاتفاق، وأن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه أن الحكم كذا، لا يجوز تقليد غيره بالاتفاق أيضًا، أي: لا خلاف في ذلك. اهـ.
ونقل ابن القيم في (إعلام الموقعين) عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين عند الواقعة التي سأل عنها، وإنما سؤاله عن حكمها وما يعمل به فيها، فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه. اهـ. وراجع للفائدة الفتويين: 17519، 32435.
وأما السؤال عن الكفر في هذه الحال: فلا يصح إطلاق الحكم به، وإنما يكون ذلك مثلاً إذا اعتقد حل الحرام فيكون مستحلاً، فالحكم هنا كالحكم في بقية أنواع الكذب على صاحب الشرع.
جاء في تفسير ابن عرفة، عند قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (البقرة: 204): قيل لابن عرفة: وهذا من الكذب على الله.
وقد ذكر ابن التلمساني فيه قولين: قيل: إنه كفر، وقيل: لا؟ قال ابن عرفة: إنّما الخلاف في الكذب على الله في الأحكام؛ كقوله: أَحَلّ الله كذا وحرم كذا.
وأما قول القائل أي الحالف: لقد كان كذا والله يعلم أنّي لصادق، فهو يمين غموس وليس من ذلك القبيل. اهـ.
وقال النووي في شرح حديث: من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار: اعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد ... منها: تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان يقول في درسه كثيرا: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر، وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وإنه هفوة عظيمة، والصواب ما قدمناه عن الجمهور. ومنها: أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب، والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. اهـ.
وقال ابن حجر في (فتح الباري): إن قيل: الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. ومال ابن المنير إلى اختياره، ووجَّهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام، أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر، والحمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. اهـ.
وقال الذهبي في (الكبائر): قال ابن الجوزي في تفسيره: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة. ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك. اهـ.
وذكر مثل ذلك الهيتمي في (الزواجر عن اقتراف الكبائر) والمناوي في (فيض القدير).
وهذا الكفر يتحقق في مسألة تبديل الشريعة، حيث يجعل حق التحليل والتحريم ومنصب التشريع، لغير الله تعالى.
جاء في (مسودة آل تيمية في أصول الفقه): ومن سلك هذا المسلك أزال ما شرعه الله برأيه، وأثبت ما لم يشرعه الله برأيه، وهذا هو تبديل الشرائع. اهـ.
واتباع أمثال هؤلاء في تحريم الحلال، وتحليل الحرام مع العلم بأنهم بدلوا الشرع نوع من الكفر -والعياذ بالله-.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ـ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله ـ يكونون على وجهين:
(أحدهما): أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا -وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم- فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركاً مثل هؤلاء.
و(الثاني): أن يكون اعتقادهم وإيمانهم (بتحريم الحرام وتحليل الحلال) ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ... ثم ذلك المحرم للحلال، والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. اهـ.
وقال أيضا: والإنسان متى حلل الحرام -المجمع عليه- أو بدل الشرع -المجمع عليه- كان كافرًا مرتدا باتفاق الفقهاء.
وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 51199، 167485.
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

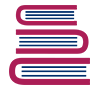
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات